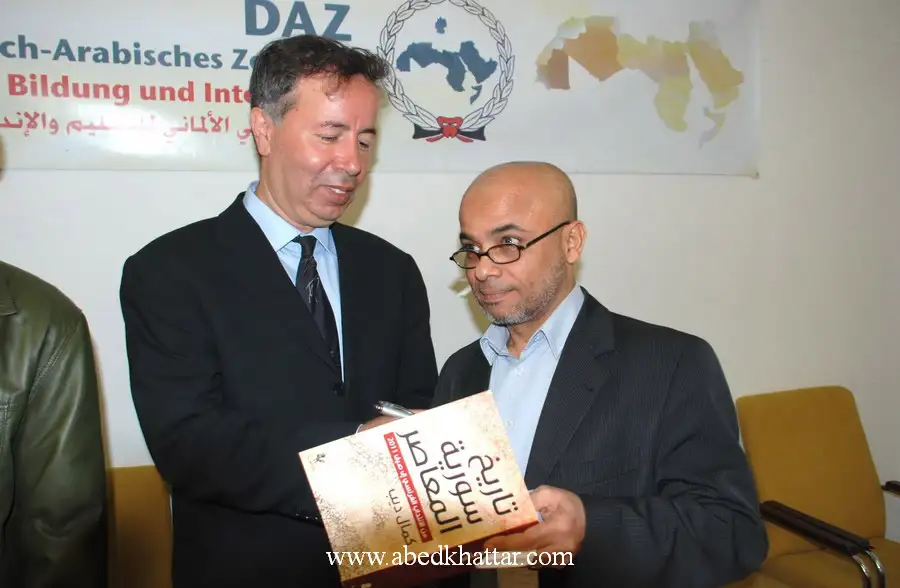محاضرة بعنوان حياة الثقافة العربية وموتها من بيروت / كمال ديب
محاضرة في المركز العربي الالماني “حياة الثقافة العربية وموتها من بيروت” العالم اللبناني والمؤلف د. كمال ديب

السبت 19 ايار 2012 برلين عبد خطار
المركز العربي الالماني يستضيف العالم اللبناني والمؤلف كمال ديب في مركزها في شارع اوثمان شتراسي 23 حيث رحب السيد حسن همدر به وبالحضور الكريم مفتتحا المحاضرة .
حيث تناول المؤلف د. كمال ديب في كتابه الأخير موضوعا شيقا هو كيفية تبادل المؤثرات بين الشرق والغرب عبر مئات السنين، فضلا عن الوضع الراهن للمقارنة الثقافية في عصرنا الحالي. ووصف الضيف في محاضرته فريدريش نيتشه Friedrich Nietzsche بأنه واحد من أهم المفكرين والفلاسفة والشعراء الألمان، مشيدا بتأثر المفكرين به في الشرق والغرب على السواء.
ولم يُخف أنه يعتبر مؤلف نيتشه الرئيسي ” هكذا قال زُرادشت ” بأنه الإنتاج الفكري المحبب، لا لديه فحسب بل ولكثيرين غيره من العرب الذين يعتبرون الاطلاع عليه فرضا. ويكفي الاطلاع مثلا في الأدب الألماني على رواية الشاعر الألماني الشهير هيرمان هسه Hermann Hesse كي يتضح مدى تأثير مؤلّف الفيلسوف الألماني هذا على الفكر. وأعرب الضيف عن رأيه في أنه كان لنيتشه أيضا أثر على الأدب العربي يبدو بوضوح للعيان عند قراءة ديوان ” النبي ” لخليل جبران الذي ألفه في عام 1923 أي في تزامن تقريبي مع رواية هيرمان هسه. ونود د. كمال ديب بأن هناك عناصر مشتركة في المؤلفات الثلاثة، أهمها : سرد حياة ” نبيّ ” وآثاره، نبيّ حاول التبشير بحكمه بين البشر، فضلا عن أن هذه المؤلفات مضمّخة بالروحانيات.
وأعرب د. كمال ديب عن رأيه في أن لبنان لا يختلف بتاتا عن العالم العربي، بل إنه يعكس بصورة نموذجية تطورات الساعة والتوجهات المستقبلية. ومضى إلى القول بأن العاصمة بيروت في الدرجة الأولى ظلت طيلة عشرات السنين مصدر إشعاع فكري وإنتاج ذهني. وأكد أن الحياة الفكرية في بيروت كانت بمثابة إيحاء بالنسبة إلى العالم العربي بأسره، وتبعا لذلك كان لأي تطور سلبي في الحياة الفكرية البيروتية عواقب غير محمودة في شتّى أنحاء الاقليم العربي.
.وهكذا فإن النقاش المتسم بالحيوية عقب المحاضرة، يُعزى في الواقع إلى موضوعها، علاوة على النظريات الاستفزازية التي طرحها المفكر المحاضرز غلا أنه لا يجدر بنا أن نغفل هنا إدارة النقاش التي تولاها البروفسور د. أودو شْتايْنْباخ المدير السابق لمعهد الشرق في هامبورغ، الذي انتقد بشدة تراجع الاستعداد للحوار.
كانت المفاجأة السارة هي أن د. كمال ديب أعلن أن اهتمامه بألمانيا ينمو باطراد، وأنه يريد الانتساب إلى جمعية الصداقة العربية الألمانية.
بعض من انطباعات الأمسية تجدونها هنا
“عدُت في طيراني إلى الوراء، باتجاه موطني، وبسرعة أكبر فأكبر: هكذا حللتُ بينكم في بلاد الثقافة. ولو عنّ لأحد أن يرفع عنكم كل الأحجبة والأغطية وكل ألوانكم وايماءاتكم لما بقي بين يديه سوى ما يكفي لإفزاع الطيور”.
إنّ لديهم شيئاً يفخرون به. ماذا يسمّون ذلك الشيء الذي يجعلهم فخورين؟ ثقافة يسمّونه، وهو ما يميّزهم عن رعاة الماعز.
هنا موطن كل الرذائل وكل مَفسَدة. لكن يوجد هنا أيضاً أهل فضائل.
هناك الكثير من الفضائل الموظفّة الحاذقة. هناك الكثير من الورع أيضاً وكثير من التقوى المتدلّق وألسنة التعبّد المتملّقة أمام إله العساكر والحروب.
هكذا تكلّم زرادشت، فريدريش نيتش
1-في تعريف الثقافة والمثقفين
كان العرب القدماء في الجزيرة يتمتّعون بخمس معارف أصبح اسمها في التراث “علوم الإعراب في عصور الجاهلية”. وهذه المعارف هي:
• “القيافة”، في ما يحتاجه المسافر في تقفّي الأثر ومعرفة جغرافية الصحارى والبوادي.
• و”العرافة” في ما يحتاجه المرء من معرفة الغيب والمجهول.
• و”الفراسة”، في ما يمكّن المرء من التفرّس في الوجه ومعرفة المكنون.
• و”الكي”، في ما يحتاجه المرء من علاج سبق عصر الطب عند العرب، فكل علّة جسدية أو مرض خبيث كان النار علاجه الأول (من كي الحرق أو اللسعة أو مداواة النزلات الصدرية بكبسات النار).
• وأخيراً، “كيد النساء”، فيما تحتاجه الانثى في ذلك الزمن للذود عن نفسها تجاه الرجل المتفوّق جسديّاً والمهيمن اجتماعياً واقتصادياً في عصر كان وأد الأنثى الرضيعة قيد الممارسة.
هذه المعارف البدائية في الفطرة العربية تطورّت في عصر العرب الذهبي في بغداد ودمشق والقاهرة والأندلس:
فالقيافة أصبحت علوم الجغرافية والهندسة، والعرافة أضحت مدارس فلسفية وكلامية وفقهية،
والفراسة أصبحت علوم انسانية كانت أساس علم النفس،
والكي كان أساس طب العرب الذي تعلّمته أوروبا عبر الأندلس وابن سينا، وكيد النساء أدّى إلى الابداع الفني والايروسية حسب نظريات فرويد (وهذا حديث آخر).
لم يكن التطوّر ممكناً لو لم تمتزج الفطرة العربية والعقيدة الدينية مع حضارتي الفرس والاغريق. وأصبح هذا المزيج بين الحضارات من علوم الأقدمين وإبداع المجدّدين أساس كل ما أعطاه العرب للعالم من فكر وعلوم من القرن السابع الميلادي حتى القرن الخامس عشر. إذ كان العرب والامبراطورية الاسلامية منطلق العلوم والمعارف للعالم كلّه.
مصطلح الثقافة ليس فقط مقاربة إبداعية بل أيضاً مقاربة إنتروبولجية. والثقافة كعملية إبداع تعني نتاجات الشعر والأدب والرسم والنحت والمسرح والموسيقى والسينما والعمارة. أما الثقافة بمعناها العالي فهي تتضمّن اللغة والعادات والتقاليد والتطوّر التاريخي الذي يجمع شعب أو جماعة إلى قطعة من الأرض.
أول شروط الإبداع أن يكون المثقّف حائز معرفة عالية عن الثقافة التي ينتمي إليها. وثاني شروطه أن يكون متمتّعاً بالحرية. فالثقافة هنا إذاً على علاقة بالتعبير والتعبير يتطلّب حرّية، وهذه الحريّة كانت موجودة نسبياً في بيروت. المدينة االتي جَذَبت مبدعي الدول العربية المجاورة في الخمسينات والستينات والسبعينات من القرن العشرين، وما زالت تجذبهم اليوم ومنذ انتهت الحرب، ولذلك عُرفت هذه المدينة عاصمة ثقافية فعلية للمشرق. وعلى هذا، يمكن تأسيس “ثقافة” بمعناها العالي الانتروبولوجي حيث يعمّ الإبداع الثقافي رابطاً بين شعوب وبلدان المشرق العربي تصبح مع الوقت قريبة ثقافياً من حيث اللغة والتقاليد الحضارية والمشارب والأذواق التعبيرية. فتلعب الثقافة دوراً خطيراً أين منه الأحزاب السياسية. ثم انّ الإبداع الثقافي هو عملية تجدّد لا تنتهي أبدًا، تنفي مقولة حصول مجتمع ما على علوم وآداب وفنون تجعله في أعلى قمة السلم الثقافي. إذ أنّ مجتمعات أخرى هي في حال دينامكية دائمة ستستوفي يوماً ما شروط الابداع ونتاجه، وقد تسبق غيرها من المجتمعات. فالإثنيات بما هي أجساد لكلّ منها عباءته الثقافية، ليست كائنات جامدة كالطبقات الصخرية، بل هي خاضعة لنفس قوانين الفيزياء ويمكن أن تتراجع أو تتقدّم. فليست الثقافة احتكاراً أوروبيّاً صرفاً وليست ضآلة الابداع الثقافي نعت دائم يلبس العرب وغيرهم من شعوب العالم الثالث.
مفهوم الثقافة أمر أساسي في العلوم الانسانية والاجتماعية من سيكولوجيا وسوسيولوجيا وأنتروبولوجيا. ويستعمل ابن خلدون “الثقافة” بالمعنى المتداول أوروبيّاً اليوم، Kultur، على أنّها مجموعة الأشكال و المظاهر لمجتمع معين، تشمل عادات وممارسات وقواعد ومعايير كيفية العيش والوجود، من ملابس ودين وطقوس وقواعد سلوك ومعتقدات وتراث. وهذا الاستعمال أو التوظيف هو التعريف العالي للثقافة.
أما على المستوى الأدنى، فالثقافة هي المعلومات والمهارات التي يملكها البشر. وهو المعنى الأكثر شيوعاً في العالم العربي. أي أنّ المثقّف في ذهن الناس هو حالة الفرد العلمية الرفيعة المستوى، وبهذا يصبح المثقف حالة اجتماعية. ولكن على مستوى المجتمع ككّل، وعندما يقال ثقافة لبنانية أو عربية، يدخل المعنى العالي للثقافة أي مجموعة العادات والقيم والتقاليد التي تعيش وفقها جماعة أو مجتمع بشري. فعلى المستوى الفردي يعيش المثقف حياة حداثوية حضارية، ويفرض نتاجه الثقافي نفسه على مجتمعه الذي يتهذّب به.
أمّا غير المثقف فهو يسلك سلوكاً يلائم البيئة الاجتماعية التي تمنحه قدراً معقولاً من الثقافة: التعامل اللائق مع الآخرين، التراث الديني وطقوسه، لهجة الكلام وتعابيره، تذوّق الطعام وطريقة اللباس، الخ. وكلما زاد نشاط الفرد و مطالعته واكتسابه الخبرة في الحياة زاد معدل الوعي الثقافي لديه، وأصبح عنصراً بناءً في المجتمع، يمارس قيّم الحق والخير والجمال. والثقافة هنا بمعناها العالي يتمّ تعليمها ونقلها من جيل إلى آخر وتصبح مجموعة أشياء متأصّلة بين أفراد ذلك المجتمع. ومن هذه الأشياء الموسيقى الشعبية ورقص الدبكة والتقاليد المحببة التي تصبح قيماً تتوارثها الأجيال (الكرم عند العرب، الدقة عند الأوروبيين، الصدق عند الألمان)، أو مظاهر سلوكية أو مراسم تعبديّة أو مراسيم الزواج . فيُقصد بالثقافة الكيان المادي والروحي للمجتمع ويدخل في ذلك التراث واللغة والدين وعادات المجتمع ونشاطه الحضاري. ويمكن ايضاً فكفكة هذه الثقافة العالية لأنّ مجتمع بلد ما يتكون عادة من مجتمعات فرعية (مدينة، قرية، …)، التي هي بدورها تتكوّن من عدة أحياء، وفي كل حي بضعة شوارع وفي كل شارع أبنية وفي كل مبنى شقق تسكنها أسرة أو أسر التي هي بدورها مجموعة أفراد لكل فرد منها ميوله وخصوصيته.
قبل عامين وضعتُ كتاب – بيروت والحداثة: الثقافة والهوية من جبران إلى فيروز دّونت فيه بإيجاز تأريخ مائة عام من الثقافة في بيروت وتحدّثت عن قصد وتعمّد، بعيداً عن الاختيار العشوائي، عن جبران خليل جبران وميخائيل نعيمة وإدوارد سعيد وهشام شرابي والأخوين رحباني وفيروز وأنيس فريحة وأدونيس وخليل حاوي ونزار قباني ومحمود درويش وزياد الرحباني وعشرات المبدعين الآخرين في سياق فصول الكتاب. ثمّ أنّي ضيّقت بيكار اختيار المواضيع، فاقتصر على بعض أنواع الثقافة المعاصرة في بيروت، كالأدب والفكر والشعر والمسرح والسينما والأغنية والرقص. فلم أتطرّق مثلاً إلى الرسم التشكيلي والعمارة والنحت والزجل (شعر العامية) والتراث والرياضة والمطبخ.
نهضة بيروت كعاصمة ثقافية بنكهة عربية أوروبية مصدره نمو “الفكرة اللبنانية” و”فكرة العروبة العلمانية الديمقراطية”، وما قدّمته هاتين المدرستين الفكريتين، منذ نهاية القرن التاسع عشر وحتى 1975، من فنون جميلة، وما أنجبته من شعر وفكر وأدب وكتب وموسيقى ومسرح، وما وفّرته بيروت كمنفى لمثقفي العرب وخصاة من فلسطين وسورية والعراق. وأذا كان ثمّة تراجع لدور بيروت هذا، فهو مرتبط بطغيان التفسّخ الطائفي والمذهبي مكان “الفكرة اللبنانية” وحلول الأصولية الدينية الاسلامية مكان “فكرة العروبة العلمانية الديمقراطية”.
وعلى هذا الأساس بنيتُ فصول الكتاب الإثني عشر:
• في الفصل الأوّل قارنت بين الأديب الألماني هرمن هسّه واللبناني جبران خليل جبران. وغايتي تقديم نموذج لإبراز عالمية الأدب اللبناني وتنوّع مناهله، ومن ثم كشف كيف أنّ أديبين، واحدهما لبناني والآخر ألماني، قد لجأا إلى الفكر الأوروبي والتراث الآسيوي في أعمالهما، وبصفة مستقلّة، في أوائل عشرينات القرن العشرين، وأنتجا مؤلفات خالدة.
• وفي الفصل الثاني تطرٌّقت إلى المفكّرَين الفلسطينيّين، هشام شرابي وإدوارد سعيد، حول الثقافة وهموم المثقّف، ما شكّل محوراً نظريّاً للكتاب، وبوصلة أعود إليها فيما يليه من فصول. • وفي الفصل الثالث تحدّثت عن الفترة الانتقالية من عصر جبران النهضوي (العشرينات وأوائل الثلاثينات) ودور زميله ميخائيل نعيمة في فترة التحوّل في الثلاثينات والأربعينات، وصولاً إلى عصر بيروت الأدبي الذهبي الذي بدأ في الخمسينات.
• ثم ركّزت على الأخوين رحباني وفيروز في الفصلين الرابع والخامس، وأثر هذا الثلاثي على عقدي الخمسينات والستينات، وناقشتُ كيف انبثقوا من رحم “الفكرة اللبنانية” وامتطوا التراث والفولكلور للمساهمة الهامة في صنع الهوية اللبنانية.
• أمّا حياة بيروت الثقافية في فترة الحرب في السبعينات فقد تحدّثت عنها في الفصل السادس، لأسلّط بعد ذلك الضوء على حقبة الشاعر خليل حاوي وسنواته العشرة الأخيرة قبل انتحاره في الفصل السابع.
• وفي الفصول التالية، ركّزت على انتعاش الأدب العربي والشعرية العربية في بيروت قبل الحرب ثم مغادرة كبار الكتّاب العرب لبنان. فأخصّص الفصل الثامن عن محمود درويش ونزار قبّاني، والفصلين التاسع والعاشر عن أدونيس.
• أمّا في الفصلين التاليين، فإنّي أطرح عودة الأمل بولادة ثانية لبيروت عاصمة ثقافية في سنوات ما بعد الحرب، من خلال معالجتي لمسرح زياد الرحباني في الفصل الحادي عشر وللسينما اللبنانية الجديدة في الفصل الثاني عشر.
2-التحدي الثقافي عند العرب
في بداية القرن الحادي والعشرين أصبحت المنطقة العربية هامشية على كافة الأصعدة الاقتصادية والعسكرية والفكرية والابداعية. وباتت مراكز الأبحاث والعلوم والقوة في أميركا واليابان والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا. لم يعد ثمّة فكر عربيّ ينتقل إلى الواقع المعاش وبات الشاعر أدونيس يقول إنّ العرب حضارة قد زالت، ويعزّي الشاعر نزار قباني بموت العرب. أمّا الفكر الذي ظهر في أواسط القرن العشرين فهو لم يصل إلى مرحلة التطبيق (الوحدة العربية، تحرير فلسطين، التطوّر التقني، تحرير الانسان العربي، بناء “الاشتراكية” العربية، الدولة العلمانية الديمقراطية، إلخ). وفي المقابل، حقّقت الثورات الفرنسية والأميركية والروسية والصينية ذواتها ووصل المجتمع الغربي إلى أهدافه – أو إلى معظمها – من خلال سلسلة الأفكار التي وضعها مفكرّوه وأنبياؤه الجدد (جان جاك روسو وآدم سميث وكارل ماركس وجان ستيوارت ميل وجون لوك وجورج هيغل وسيغموند فرويد وألبرت اينشتاين وآخرون).
قبل 40 عاماً كتب المفكّر الفلسطيني وكان مقيماً في أميركا، بحثاً عنونه المثقفون العرب والغرب . ومن خلاصات هذا البحث أن شرابي ميّز بين مثقف عربي مسلم ومثقف عربي مسيحي. وأنّ الأول أسير التحريم، لا ينفصل عن الموروث الديني والمقدّس مهما بلغت درجة ثقافته وانفتاحه على الغرب. فيما الثاني، المثقف المسيحي، يمتص الثقافة الغربية ويتبنّاها ويبدع فيها كأنّها ثقافته، ولا خفر عنده في نبش الموروث الديني. وبعد شرابي، تابع إدوارد سعيد، مفكّر فلسطيني آخر كان مقيماً في أميركا أيضاً، نفس الخطوط العريضة التي بدأها شرابي، في بحثٍ أُختير له عنوان بالعربية هو صور المثقّف ، وفيه شروط المثقّف وقول الحق في وجه السلطة، نشره عام 1994. إدوارد سعيد رفع حاجبيه مستغرباً: ماذا يفعل المثقفون العرب في أحضان الأنظمة ولماذ لا يحدثون خرقاً في جدار برلين العربي؟ ولماذا تسقط الدكتاتورية في كل مكان إلا عند العرب؟ ولعل سؤال إدوارد سعيد الأهم عندما يشاهد قمع كتّاب عرب في مصر وسورية وغيرها: متى يستطيع المفكّر في العالم العربي مناقشة المقدّس؟
في كتاب صور المثقّف، يطرح إدوارد سعيد تعريفات عدّة للمثقف تتراوح بين المثقف كناشط إجتماعي والمثقف كملك فيلسوف. والمثقفون هم الأشخاص الذين يتحلّون بموهبة استثنائية والحسّ الأخلاقي الفذّ، ويشكلّون ضمير البشرية ولكنّهم ليسوا معصومين وقد يقعون ضحية الإغراءات ويخونون قضية الثقافة، فيتخلّون عن رسالتهم ويعرّضونها للشبهة. أما المثقف الحقيقي فهو لا يجب أن يقل مبدئية عن يسوع المسيح وسقراط وفولتير وغوتيه. فيدافع المثقّف عن المعايير الأزلية للحق والعدل، وهي لكمالها معايير ليست من هذا العالم، مقارنة بعامة الناس المهتمين بالفائدة المادية والتقدّم الشخصي وبإقامة علاقة وثيقة مع السلطة وأصحاب النفوذ السياسي. ولكن المثقفين لا ينفصلون كليّاً عن المجتمع وعن الواقع من حولهم، ولا يقيمون في أبراج عاجية أو في عزلة شديدة ولا يكرّسون حياتهم لمواضيع مبهمة ومسائل باطنية. فالمثقف الحقيقي يكون في سعادة كبرى عندما تحرّكه عاطفة وجدانية ومبادىء الحق والعدل، فيشجب الفساد ويدافع عن الضعيف ويتحدّى السلطة القمعية والناقصة: مِن ارنست رينان الذي شجب ارتكابات نابوليون العنيفة إلى نيتشه الذي شجب الوحشية الإلمانية ضد فرنسا عندما احتلّتها عام 1871. وأسوأ ما يرتكبه المثقفون هو أن ينضووا في لواء السلطة فيتخلّون عن واجبهم الاخلاقي لكي يساعدوا الطبقة السياسية – الاقتصادية الحاكمة في ترويض الناس و”تنظيم المشاعر الاجتماعية”. ولعل هذا ينطبق إلى حدّ ما على مثقفي لبنان منذ اندلعت الحرب عام 1975 وحتى اليوم حيث يشارك بعضهم، بتحيّز سياسي، في إذكاء الروح الطائفية وإطلاق عنان غوغاء الجماهير والتعصّب الشوفيني وأحياناً العنصري، وتبرير المصالح الطبقية للفاسدين في المجتمع. ويقول إدوارد سعيد إنّ الحكومات إنّما تريد أن يتحوّل المثقفون إلى خدّام لها يحوّلون الأنظار عن أعداء البلاد الطبيعيين بابتكار عبارات ملطّفة وقاموس لغة خشبيّة ونظام كامل من العبارات “الأورويليّة” (نسبة إلى جورج أورويل) المقنّعة التي يمكنها أن تخفي ما يجري باسم النفعيّة المؤسساتية و”الشرف القومي” .
ولا يملك المثقف خيارات عدّة. فإمّا أن يختار التكلّم بشجاعة وبدون تردّد ضد أعمال الظلم السلطوي والقمع والحماس الشوفيني والقومي الأعمى، وإمّا أن يسير كالأغنام في القطيع. وهنا يشير إدوارد سعيد إلى أنّ بندا لم يقف مع عقيدة ضد أخرى ونظام ضد آخر وموقف سياسي أو اجتماعي ضد آخر. بل إنّه انتقد بشدّة المثقفين الذين وقفوا مع النازيين في أوروبا والمثقفين الذين تحمّسوا للشيوعيين بدون أن يروا فيهم ما يستوجب الانتقاد. من هنا أهمية دور المثقف وميزته عن الآخرين في المجتمع، كشخص قادر على قول الحق في مواجهة السلطة، كفرد قاسٍ، وبليغ وشجاع إلى درجة لا تُصدّق وغاضب لا يعرف أي قوّة دنيوية تكون كبيرة ومهيبة جدّاً بحيث لا يمكن انتقادها وتوبيخها على سلوكها.
خصص إدوارد سعيد فصلاً كاملاً حول موضوع “قول الحق في وجه السلطة”. وهنا يرمي إدوارد سعيد قنبلته في الكتاب مختصراً مسيرته الحياتية كمثقف عربي: “أنا مستعد أن أذهب أبعد من ذلك وأقول إنّ على المثقّف الانهماك في نزاع مستمر مدى الحياة مع جميع الأوصياء على الرؤيا المقدّسة أو النص المقدّس، الذين مغانمهم غفيرة وظلمهم لا يطيق أي اختلاف في الرأي، وبالتأكيد أي تنوّع. إنّ حريّة الرأي والتعبير المتصلّبة هي المعقل الرئيسي للمثقف العلماني، فالتخلّي عن حمايته أو تحمّل العبث بأي من أساسته هو في الواقع خيانة لرسالة المثقف.. وليست هذه مجرّد قضية لمن هم في العالم الاسلامي، بل لمن هم أيضاً في العالمين اليهودي والمسيحي. فحريّة التعبير لا يمكن نشدانها إجحافياً في منطقة ما وإغفالها في أخرى .
ويختار إدوارد سعيد المثقّف الفرنسي اللامع ألكسي دي توكفيل الذي وضع كتاب الديمقراطية في أميركا، كمنافق لا يلتزم بالقيم العليا للمثقف:
فبعد أن كتب دي توكفيل تقييمه للديمقراطية في أميركا وانتقد المعاملة الأميركية السيئة للهنود والعبيد السود، كان عليه أن ينتقد لاحقاً السياسات الاستعمارية الفرنسية في الجزائر في أواخر الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي، عندما شنّ جيش الاحتلال الفرنسي بقيادة الماريشال بيجو حرباً وحشية للقضاء على المقاومين الجزائريين المسلمين.
وأنّ القواعد نفسها التي اعتمدها دي توكفيل في احتجاجه انسانياً على ارتكاب الأميركيين أعمالاً محظورة قد تجاهلها لمصلحة الاستعمار الفرنسي في أفريقيا. “فالمجازر لا تثير مشاعر دي توكفيل، والمسلمون كما يقول ينتمون إلى ديانة أدنى منزلة ويتحتّم تأديبهم. وباختصار، فإنّ القيم الانسانية العامة الظاهرة في لغته (لغة دي توكفيل) عن أميركا يتمّ تجاهلها، لا بل وتتجاهل عمداً عندما يتعلّق الأمر ببلاده فرنسا حتى لو اتبّعت سياسات مماثلة في لاإنسانيتها” .
ويقدّم إدوارد سعيد مثلاً آخر للنفاق يمثّله المفكّر الانكليزي جون ستيوارت ميل، الذي يُعتبر من مؤسسي الفكر الليبرالي في الفلسفة الغربية. وستيوارت ميل هذا صاحب آراء عنصرية في أنّ الحريات الديمقراطية التي يتمتّع بها الشعب الانكليزي لا تنطبق على الهند التي كانت تستعمرها الامبراطورية البريطانية آنذاك. وهكذا كان دي توكفيل وستيوارت ميل يعيشان في عصر الامبريالية ويقدّمان أفكاراً مفيدة لأمّة كل منهما ولكنّها كانت تعني الاحتفاظ بحق القوّة الأوروبية وسيطرتها على الشعوب الأخرى. وكانت شعوب العالم خارج أوروبا بالنسبة لهذين المفكّرين وسواهما من مفكّري أوروبا تافهة وثانوية. “إضافة إلى ذلك وفقاً للغربيّين في القرن التاسع عشر، لم يكن في تلك الفترة وجود لشعوب أفريقيّة أو آسيويّة مستقلّة ذات شأن لتتحدّى القساوة الوحشية للقوانين التي طبقّتها الجيوش الاستعمارية على ذوي البشرة السوداء أو السمراء الذين كان قدَرُهم أن يُحكموا”.
ولكن إذا كان مفكّروا القرن التاسع عشر بهذه النمطية القومية العنصرية، فإنّ مفكّري القرن العشرين لم يكن أمامهم أيّ مبرّر لتأييد حكومات بلادهم في دعم الاستعمار والعدوان ضد شعوب العالم الثالث. فقد وصلتهم كتابات مفكّري ومناضلي العالم الثالث من أجل الاستقلال والعدالة وحقوق الانسان، ووصلتهم تفاصيل حركات التحرّر في العالم الثالث وما ترتكبه بلادهم الامبريالية من اضطهاد ومجازر في أفريقيا وآسيا. وفي هذا السياق يسجّل إدوارد سعيد مبدأً آخر في واجبات المثقّف: “أنّك إذا رغبت في دعم العدالة الانسانية الأساسية فعليك أن تدعمها للجميع، وليس فقط انتقائياً لمن تصّنفهم جماعتُك أو حضارتُك أو أمّتك، أهلاً لها. من هنا، فإنّ المشكلة الجوهرية هي كيفيّة التوفيق بين هويّة المرء وحقائق ثقافته ومجتمعه وتاريخه، وبين واقع الهويّات والثقافات في الشعوب الأخرى. ومن غير الممكن تحقيق هذا التوفيق بمجرّد الإصرار على تفوّق الأمّة التي ينتمي إليها المرء. فالخطابة الحماسية عن أمجاد ثقافتنا “نحن” أو انتصارات تاريخنا “نحن” لا تستحقّ طاقة المثقف، وبخاصة هذه الأيام التي تتألّف فيها مجتمعات عديدة جدّاً من أعراق وخلفيات متنوّعة بحيث تقاوم أي صيَغ تصغيرية” .
لقد نكثت الولايات المتحدّة عشرات قرارات مجلس الأمن الدولي عندما صبّ ذلك في مصلحتها ضد مصالح الشعوب الأخرى، وغزت بلداناً صغيرة وفقيرة مثل بنما وغرينادا وفيتنام وكمبوديا ولاوس ودعمت دكتاتوريات حول العالم وقامت بأعمال أغتيال لقيادات مخلصة لأوطانها، وتوّجت هذه الأعمال بغزو واحتلال أفغانستان عام 2001 والعراق عام 2003. ولكن طيلة هذه العقود لم تظهر فئة من المثقفين الأميركيين تنتقد وتعارض هذا السلوك الهمجي في التعاطي مع مصائر الشعوب الأخرى، لا بل تجدهم يؤيّدون هذه الحروب. وبحسب إدوارد سعيد، فإذا انتقد المثقف الأميركي العراق ونظامه في عهد صدام حسين فإنّ ذلك يستتبع أن تستحق الولايات المتحدة الانتقاد نفسه. ولكن المثقف الأميركي لم يفعل، “لأنّ دوافعنا كأميركييّن أكثر سمّواً وصدام هو هتلر أمّا “نحن” فتحرّكنا دوافع ناجمة بالدرجة الأولى عن محبّتنا للغير ونزاهتنا ولذا فإنّ حروب أميركا عادلة”.
وحتى عندما ترتكب إسرائيل المجازر وتشنّ الحروب على بلاد أخرى ليست حليفة لأميركا، فإنّ مثقفي أميركا لا يتنقدون هذه الدول الحليفة لأميركا، فيما كانوا يشغلون أنفسهم بانتقاد جرائم الاتحاد السوفياتي السابق. أمّا عن الاجتياح الأميركي الشنيع للهند الصينية (منذ أواخر الخمسينات وحتى أواسط السبعينات)، وما نجم عنه من تدمير مذهل أنزل بمجتمعات صغيرة في غالبها فلاحية، قد قصر مثقفو أميركا اهتمامهم على كسب حرب فيتنام على أنّها كانت ضد الاتحاد السوفياتي، و”إلى جهنّم” حسب رأيهم ما ترتكبه أميركا من آثام. فهل من الجائز للمثقّف المعاصر في زمن بدا وكأنّ المعايير الإخلاقية الموضوعية والسلطة الواعية هي سيدة الموقف، أن يكتفي المثقف هكذا ببساطة إمّا بتقديم الدعم الأعمى لسلوك بلاده والتغاضي عن جرائمها وإمّا أن لا يبالي “لأنّ كل الناس تفكّر هكذا” وأنّ “هذه هي حال الدنيا”؟ فالمثقّف الحقيقي ليس هذا المحترِف الذي مسخته السلطة لخدمتها وهي سلطة متزلّفة لا حدود لعيوبها، بل هو دوماً في موقع يتيح له المجال للاختيار، ويصرّ أكثر من غيره على المبادىء التي تمكّنه فعلاً من قول الحقّ في وجه السلطة.
أمام انهيار القيَم الانسانية وشرعة حقوق الانسان وكافة العهود والقوانين التي وضعتها الهيئات الدولية ووافقت عليها كل الدول، وأمام واقع أنّ هذه المبادىء باتت حبراً على ورق عندما تعاملت معها السلطات وداعميها من المثقفين المحترفين بأسلوب “عملي” يتغيّر وليس من موقع ثابت، فإنّ معايير سلطة القوّة المادية هي هكذا وتختلف ولا تنطبق على المثقف الذي واجبه أن لا يفقد البوصلة، ويبقى دوره أن يطبّق مقاييس السلوك الرفيعة التي تدعو إليها الشرعات والمواثيق والتي وقّعتها الدول ويجب أن يسير عليها المجتمع الدولي بأسره . وليس أنّ المثقف آلة تسيّرها المبادىء، فهو ليس بعيداً عن فكرة الولاء للوطن الذي يتنمي إليه، ولكن الخطر هو أن يضعف ويخاف، أو أن تصرفه ظروفه المعيشية واهتمامته وقدراته ويختفي صوته لأنّه أصبح صوتاً فردياً هو صوت المثقف. ذلك أنّ الظروف الذاتية تفعل فعلها بطريقة مخيفة. فالاحتماء في مهنة أو وظيفة تدرّ ذهباً والانتماء القومي الذي يغشي البصيرة هي من مخاطر تدهور المثقف، حتى لو ما زال ضميره يوخزه عندما يقرأ صحف الصباح. وثمّة حل وسط في الاعتراف بأنّ لا أحد يقدر أن يتكلّم في كل القضايا كل الوقت. ولكن على المثقّف أن يحافظ على الحدّ الأدنى ويحافظ على واجبه الأساسي في مخاطبة القوى ذات السلطة الشرعية وذات الصلاحية في مجتمع المثقف نفسه. وهي قوى من حق المواطنين محاسبتها وبخاصة عندما تمارس سلطاتها في حرب غير متكافئة ولاإخلاقية بشكل سافر، أو في منهاج متعمّد من التمييز والقمع والوحشية الجماعية. وعلى المثقّف الأميركي أن يعترف أنّ بلاده أميركا هي مجتمع تعدّدي من مهاجرين جاؤوا من اصقاع الأرض، بلد ذو موارد وانجازات مذهلة، ولكنّ ثمّة مظالم كثيرة تقع داخل أميركا وتدخّلات في الخارج لا يمكن إغفالها. فلا يكون صمته على كل هذا إلا خيانة لواجبه.
اجتهد إدوارد سعيد في توظيف مشروعه النقدي في تفكيك الفكر الغربي ونقد الخطاب الناتج عنه، وتوصّل إلى أنّ التفريق بين شرق وغرب هو في صميم ثقافة الامبريالية، وأنّ مفكّري الغرب قد اخترعوا “الآخر” الشرقي والعربي والمسلم تمييزاً للشخصية الغربية عن الآخرين الذي يقعون في أدنى سلّم الحضارة. واعتبروا أنّهم هم أصحاب العقل والمنطق المتسلّح بالعلوم، وأنّ هذا الشرق الذي استعمروه “لاعقلاني” و”غير متحضّر”. وجاء في سياق مشروع إدوارد سعيد سلسلة كتب وعشرات المقالات والدراسات التي جُمعت اثناء حياته أو بعد وفاته في كتب، منها محاضراته عن دور المثقفين في العصر الحديث، غرباً وشرقاً، ليعيد إحياء الدور الرسالي للمثقف، الذي تلاشى في الغرب بتأثيرات العولمة ونشوء الشركات متعددة الجنسية. وقد اخذت دول الغرب الصناعي استدراج المثقفين والأكاديميين للافادة من خبراتهم وضمناً التخلّي عن مبادئهم .
قلّما نقرأ مقالاً في صحيفة لبنانية لمثقّف ينتقد فيه الزعيم الطائفي وأتباعه الطائفيين نقداً علميّاً وهادفاً بغية تحسين المجتمع، كما طالب إدوارد سعيد. وهو أقل ما يمكن أن يصنعه الكتبة الفاوستيين الذين باعوا أنفسهم لشيطان الدولار والنفط. في السنوات الأخيرة، انقسم “المثقفون” في بيروت بين معسكرين وباتوا يجترّون كتابات، تليها كتابات، تمدح الطرف السياسي الذي يعتاشون منه وتنتقد وتهاجم الطرف الآخر. وعندما تحصل مصيبة مجتمعية أو يصل لبنان إلى استحقاق مهم، يصمتون وكأنّ الأمر لا يعنيهم (كما حصل في أيار 2008). في حين أنّ دورهم الأساسي كمثقفين هو النطق – خاصة في مثل هذه الظروف – ضد السلطة في الطرفين. ما زلت أنتظر هذا المقال الذي يعني بنظر جان بول سارتر استعداد صاحبه الانتحار (كما فعل حاوي) أو على الأقل (وبدون مبالغة في الانتحار النادر) أن يكون صاحبه مستعداً أن يخسر المصدر المادي الذي يحقق له حياة مرفّهة وسيجاراً كوبياً في الفم (رأيت سيجاراً في أفواه بعض الصحافيين في بيروت). وربما لهذا السبب، أي لعدم الجرأة في وجه السلطان، ينحدر اللبناني والعربي إلى التعصّب والتناحر والتقاتل في غزة ولبنان وا …
3-هذه التحديدات الكبرى التي وضعها إدوارد سعيد قبل عشر سنوات من رحيله، تقودنا إلى ما قاله قبله هشام شرابي حول أزمة المثقف العربي أمام الفكر الغربي.
يشرح شرابي أنّ انتشار التعليم والتنوير في المشرق العربي عند مقلب القرن التاسع عشر إلى العشرين كان من الطبيعي أن يرافقه تحرّر المثقفين من القيم التقليدية، وابتعاد الجيل المتعلّم عن سائر السكان في الوقت ذاته والدرجة ذاتها التي تشرّب فيها الثقافة الجديدة. وكانت النتيجة أنّ طريق التنوّر أدّت إلى وعي ذاتي عن تمايز المثقف عما حوله وبالتالي اغترابه الاجتماعي والثقافي عن بيئته estrangement. ولكن شرابي يستدرك أنّ هؤلاء المثقفين قد اجتمعوا بعد ذلك في فئات متميّزة حسب اصولهم الاجتماعية واتجاهاتهم السياسية والثقافية: “إذ ربط المثقفون المسيحيون الذين وجهوا في قوّة نحو الثقافة الأوروبية والقيم الأوروبية أنفسهم بقيم البورجوازية الأوروبية ومُثُلها. في حين اعتبر المثقفون المسلمون، محافظين كانوا أم إصلاحيين أم علمانيين، أنفسهم معارضين للثقافة الأوروبية وللسيطرة الأوروبية” . واعتبر شرابي أنّ عدداً كبيراً من مفكّري وقادة الحركة الاصلاحية في الاسلام خرج من بيئة رجال الدين في مصر وسورية ولبنان، لأنّ تلك البيئة هي التي تتعاطى بالكتب والقراءة والكتابة وتملك مقومات مادية وعلاقات تؤهلها على نهل الثقافة، مقارنة بسواد الشعب الفقير. ومن هؤلاء جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده. وقد اشتغل هؤلاء على أسئلة تدور حول بعث الاسلام بعد قرون من الانحطاط، أبرزها اسئلة حول إمكانية مواجهة الحضارة الأوروبية. وكانت هذه الفئات هي نواة الحركات الأصولية أو الصحوة فيما بعد في البلاد العربية والاسلامية فيما بعد وخاصة منذ ثلاثينات القرن العشرين، التي دعت فيما دعت إلى وحدة المسلمين والعداء للغرب وإحياء الخلافة، الخ. ويصف شرابي هذه الفئة بأنّها التيار المحافظ في الثقافة العربية. فهي رفضت الانفتاح على التيارات الأوروبية والثقافة الغربية وعادت إلى التقليد وإلى جذور الاسلام، واستمدّت الوحي والقوة من التراث الذي تراكم عبر التاريخ. بالنسبة لهؤلاء، الماضي، وليس الحاضر، هو محور العصر الذهبي الذي يجب استعادته وأنّ الحاضر الاسلامي على علّاته لا يمكن التنكّر له بل هو نقطة البداية للانبعاث و”الأساس الوحيد لمقاومة التهديد الأوروبي”. وإذ برز من هذه الفئة مصلحون متنوّرون ومتسلحون بإدراك عقلاني، إلا أنّ اصلاحهم بقي في إطار التقليد، وكان هدفهم حماية الاسلام والمؤسسات التي يقوم عليها. كان هؤلاء المصلحون يريدون حماية الاسلام بشكل سليم واستعادة حيويته. وللقيام بذلك كان ضرورياً الاصطدام بالاسلام التقليدي الذي يتعاطف أو يتحالف مع الطبقات الحاكمة في الشرق العربي.
وخارج هذه الفئة التي أرادت أن تنهض بالشرق المسلم بالعودة إلى التراث والمقدّس، كانت ثمّة فئة ثانية تلقّنت تعليماً أوروبياً وتأثّرت بالغرب واتجهت نحو الفكر العصري العلماني. فأصدرت الصحف والمجلات وأسّست الصالونات والمراكز الأدبية والاجتماعية في القاهرة وبيروت وحلب ودمشق وبغداد. ففي بيروت صدرت مجلة الجنان للبستاني، وفي القاهرة المقتطف لنمر وصرّوف والهلال لزيدان والمنار لرضا وفي دمشق المقتبس لكرد علي، واهتمّت هذه المطبوعات بالسياسة والتاريخ والأدب والعلوم . واتجّهت هذه الفئة نحو النهضة والشعور القومي إسوة بأمم أوروبا الناهضة، واتخذّ الكثير منها طابع الجمعيات السرّية، خاصة في سورية ولبنان. ولم يكن همّها نهضة الاسلام أو إصلاحه بل العمل المعارِض للسلطنة العثمانية وتأسيس الدولة العصرية، فظهرت للمرّة الأولى في المشرق ومنذ نهاية القرن التاسع عشر وحتى ثلاثينات القرن العشرين أحزاب سياسية تراوحت بين الفكر الشيوعي والفكر القومي المصري أو السوري أو العربي، وإلى أحزاب محلية نادت مثلاً بقوميات أصغر . واتّخذ عدد كبير من قادة ومفكّري هذه الحركات القاهرة (بسبب خضوعها للانكليز المناهضين للسلطنة العثمانية وأصحاب مصلحة في وعي قومي عربي معاد للترك وفي ظل قانون مطبوعات أكثر ليبرالية) وفي جنيف المحايدة، وفي باريس التي كانت تسعى إلى نفوذ في الشرق الأدنى.
هذه الفئة الثانية كانت تسعى إلى الحداثة وتستمدّ فرضياتها ومُثُلها وأفكارها من أوروبا وليس من التقاليد الاسلامية، وأنّ عصراً ذهبيّاً يتنظر العرب في المستقبل، الذي يشبه أوروبا، وليس في الماضي.
واتضح فيما بعد أنّه حتى ضمن الفئة المثقفة ثقافة علمانية حداثوية كان ثمّة تياران لم يتغلّبا على المعطيات الانتروبولوجية للمجتمع الذي انبثقا منه، ونعني المسيحية والاسلام. ذلك أنّ الفئة المثقّفة ثقافة أوروبية علمانية حداثوية لم تهرب من واقع أنّ أفرادها في قرارة ذاتهم كانوا مسلمين ومسيحيين. وهذا يعني أنّ الفئة الأولى المحافظة والداعية إلى النهضة الاسلامية استطاعت التسلّل إلى قلب المعسكر العلماني الحداثوي. أمّا تفاصيل ذلمك، فإنّ مسيحيي الفئة المثقفة اصبحوا في ثقافتهم وميولهم وكأنّهم من أبناء الحضارة والثقافة الأوروبية، فيما اكتفى مسلمو هذه الفئة المثقفة بمبدأ العلمانية دون أن يتجّهوا في تغرّبهم أو “أوربتهم” إلى حده الأقصى كما فعل معظم المثقفين المسيحيين. ويعتبر شرابي ليس فقط أنّ “المثقفين المسيحيين برغم الاختلافات الفردية، أدركوا وتمسّكوا بالقيم والأهداف المستمدّة من الغرب، بل أنّّهم عملوا على ربط المسيحيين العرب بالغرب حضارياً. وهكذا فإنّ تبايناً أساسياً فرض حاله في موقف المسيحيين العرب من محيطهم الاسلامي. وفي المقابل، ظل المسلمون ذوو القناعات العلمانية المشابهة في شكل أساسي نافرين من الغرب ومعادين له مهما كان “تغرّبهم” تامّاً. لقد أكّد المسلم العلماني، برغم تمسّكه بالقيم الغربية والأفكار المعاصرة، على هويّته الاسلامية المستقلة” .
لعب المثقفون المسيحيون دوراً حاسماً في النهضة العربية الثقافية والحضارية منذ منتصف القرن التاسع عشر، تركت أعمق الأثر في حركة التحديث العربي وفي العقل العربي. وتميّز هؤلاء عن زملائهم المسلمين بأنّهم كانوا غرباء في المجتمع الاسلامي، خاصة في ظل الحكم العثماني. حيث يقول شرابي: “إنّ كون الانسان عربياً مارونيّاً أو أرثوذكسياً أو بروتستانتياً يضعه فوراً في علاقة سلبية مع محيطه. وكان الحكم العثماني للعربي المسلم يتمثّل حكماً أجنبياً أكثر مما يعنيه هذا الحكم لزميله العربي المسلم وإذ تاق المسيحيون أن يحرّروه يوماً فبواسطة فرنسا أو بريطانيا أو أي دولة أوروبية أخرى. وكان المسيحيون في معظم المناطق باستثناء جبل لبنان ومدينة بيروت، يشكّلون أقلية بين السكان. وكانوا مضطهدين في اثناء الحكم التركي لمجرّد كونهم مسيحيين. فكنّا نجد أنّ على أي شاب مسيحي يتمتّع بشيء من الثقافة، أن يتجاوز حواجز التمييز والعداء حتى يستطيع أن يشق طريقه في الحياة”.
لقد كان شعور الأقليات المسيحية التي لم تكن على دين الحاكم التركي ـ أوحتى على مذهبه كالشيعة – بالظلم والمرارة، كما أنّ ظروفهم الاقتصادية كانت صعبة. فكانوا يغادرون قراهم إلى المدن الكبرى كبيروت ودمشق وحلب والقاهرة. أمّا في لبنان، فقد قدم إلى بيروت عدد كبير من المسيحيين من الداخل اللبناني ومن العمق السوري، ثم غادروا بيروت إلى مصر وأوروبا والمغتربات البعيدة في الأميركتين ابتداءً من أواسط خمسينات القرن التاسع عشر. وإذ افترق المسيحيون عن مواطنيهم المسلمين بمسألة الولاء للدولة العثمانية لم يكن مصدر ما يشدّهم إلى المشرق الولاء الوطني للبلاد، لأنّها كانت بلاداً تضطهدهم، بل كان شوقهم إلى القرية والعائلة، ومن ثم إلى الأقلية الدينية التي ينتمون إليها. حتى إذا انتقل المزيد من أفراد عائلتهم إلى مكان سكنهم في الأميركتين، باتت صلاتهم بالمشرق أكثر وهناً وارتباطهم بالغرب أكثر وثوقاً. وقد استغرق الأمر عقوداً قبل أن ينمو الولاء القومي وشعور المواطنية مع المسلم في إطار عربي بعيداً عن الدولة المسلمة التي مثّلتها تركيا (ساهمت ثورة 1919 في مصر في هذاالاتجاه اللاديني). فكان المسيحي المتعلّم يتطلّع إلى أوروبا ومهيّأ أكثر لتبنّي حضارتها الحديثة، وكان صاحب الدور الهام في نقل الفكر الغربي وتفسيره للعرب ونقل القيم الغربية ونشرها في المشرق.
ويتطرّق شرابي إلى دور المسيحيين في الأدب العربي الحديث، حيث مساهمتهم الكبرى في عصر النهضة، بأنّ “الطبيعة المميّزة للمنطلق المسيحي في التراث العربي تكمن في التوجّه العلماني”، وأنّ الأدب العربي من خلال المنظار المسيحي بدا في حلّة جديدة ومفعمة بالنشاط جعلت من الممكن تحليل هذا الأدب وتقييمه وفق المقاييس الجمالية والأدبية الكونية. فُوضع العامل الاسلامي الديني جانباً وتركّز الاهتمام على التركيب والأسلوب”. ويشهد عدد المؤلفات الأدبية والشعرية التي نشرها كتّاب مسيحيين أبان هذه الفترة على هذه المساهمة، وأن ّاللغة العربية تمدّدت بالفعل في القرن التاسع عشر بتأثير مجموعتين رئيسيتين: أدباء بلاد المشرق المسيحيين ولبنان خاصة، والمترجمين المسلمين المصريين الذي نقلوا المؤلفات الأوروبية إلى العربية .
نحا الأدب العربي منحى إنسانياً بارزاً نتيجة مساهمة المسيحيين. وكان من تأثير الأدب الأوروبي على العقول والأذواق للمثقفين المسيحيين أن شكّل عاملاً مهمّاً في هذه العملية. ويجب ألاّ يغرب عن البال أنّ المسيحيين كانوا ردحاً من الزمن من المستقبِلين الأساسيين للثقافة الغربية وكانوا أوّل من سافر مراراً وتكراراً إلى أوروبا الأمر الذي جعلهم مطّلعين اطّلاعاً مباشراً على الحضارة الأوروبية. لهذا كلّه كانت التأثيرات التي شكّلت الخيال الأدبي الصاعد ووجهته غربيّة في شكل كاسح من حيث خصائصها. فلم يكن ممكناً إذاً أن تتم علمنة الأدب العربي كليّاً بواسطة حركة الترجمة من المؤلفات الأروربية. والمساهمة المسيحية المتميّزة تتمثّل في تحويل الذوق والإبداع الأدبيين عاطفياً وفكرياً” .
ساهم الأدباء والمثقفون المسيحيون بالتدريج في ظهور فكرة القومية العلمانية في أوساط العرب، وأنّ الشكل المنطقي المقبول للنظام السياسي يجب أن يكون ذلك الذي يستند إلى الولاء القومي أو الوطني وليس إلى الدين. ففكرة دولة الخلافة التي بُني عليها المجتمع العثماني والسلطنة لم تكن غير مطابقة للعقل والتقدّم والعالم الجديد فحسب، بل كانت مناقضة مع الإدراك الجديد الذي روّج له المثقفون للتاريخ العربي والهوية العربية. وعلى هذا طرح المثقفون المسيحييون العروبة كمبدأ جديد للمجتمع العربي بغض النظر عن ديانة الفرد. وكان هذا المصطلح الجديد، أي الهوية العربية اللادينية، ليس فقط نقيضاً للدولة العثمانية بل أيضاً نقيضاً للوحدة الاسلامية. وهنا كان بيت القصيد، أنّ أغلبية ساحقة من البيئة الاسلامية المحافظة، وان ارتضت مع الوقت بزوال الخلافة التركية، كان مبدأوها ولم يزل نهوض الأمة الاسلامية بأكملها.
ومن هنا عجزُ المسيحيين عن مواجهة العقل الاسلامي المحافظ وتركهم هذه المهمّة للمثقف الحداثوي المسلم. ولم يكن هذا التباين الذي برز بين مسلمين ومسيحيين داخل معسكر المثقفين الحداثويين بالأمر السهل، بل أصبح أساس كل انقسام وخلاف فيما تبقى من القرن العشرين، وصولاً إلى انحسار شبه تام للمثقفين المسيحيين وعودة بالجملة للمثقفين الحداثويين المسلمين (مع بعض الاستثناءات) إلى الحظيرة الاسلامية التقليدية منذ بداية ثمانينات القرن العشرين حتى اليوم.
رأى المثقفون المسيحيون منذ البدء أنّ التحديث يعني بالضرورة التغرّب، أي الاتجاه نحو أوروبا، وأنّ التغيير الاجتماعي (بدءاً من تحرير المرأة وحتى كافة حقوق الانسان في المجتمع) لا يمكنه أن يأخذ إلا النمط الأوروبي. ولكن الهوة البارزة في دنيا العرب والتي استغرقت صفحات الجرائد وبرامج الإذاعة والتفزة فيما بعد، لم تكن بين هؤلاء المثقفين المسيحيين والفئة المحافظة بل بين المثقفين المسلمين الداعين إلى اعتناق خفِر لمبادىء غربية والفئة المحافظة الاسلامية (بشقيها التقليدي والاصلاحي). وحتى لو لم يذهب المسيحيون بعيداً في تغرّبهم ويصبحوا غرباء لا ينتمون إلى مجتمعم المشرقي، فإنّهم لم يأخذوا على عاتقهم نقد التراث الديني والنصّ المقدّس (القرآن) كي لا يبدو الأمر وكأنّهم جماعة مسيحية تهاجم الاسلام. بل كانت هذه المهمة تقع على عاتق المثقفين الحداثويين المسلمين.
والمصيبة كانت أنّه إذا تجرّأ الحداثوي المسلم أن يتنكّب نقد التراث والدعوة إلى النظر في المقدّس، تعرّض للهجوم اللاذع والإرهاب وأحياناً القتل. ولقد بدأ بعض المثقفين من المسلمين هذه الرحلة في بدايات القرن العشرين ولكنّهم لم يكملوها. فطه حسين بدأ في التشكيك في الشعر الجاهلي عام 1926، ثم تراجع، وعلي عبدالرازق كتب الاسلام وأصول الحكم عام 1935 ثم صمت، وأحمد أمين تراجع عن بعض مواقفه. ولا يتسّع المجال هنا لاستعراض أمثلة، ولكن ثمّة تجربتيّ المصريين فرج فوده ونصر حامد أبو زيد وكذلك السوري أدونيس الذي سنعود إليه في فصل مستقل، وما عانوه من اغتيال ونفي واتهامات ليس أقلّها العمالة للاستعمار.
فإذا كانت هذه حال المثقفين الحداثويين المسلمين فإنّ المثقفين المسيحيين العرب، بنظر شرابي، “كانوا يدركون دائماً أنّهم يمثّلون أقليّة في المجتمع، وأنّهم بالتالي لا يستطيعون أن يتكلّموا باسم المجتمع ككل”. وبسبب هذه الظروف، اصبح المثقفون المسيحيون أكثر الجماعات لاإنتماءً إلى بيئتهم الحضارية والثقافية العربية وحصروا آفاقهم عن قصد لتجنّب الصراع مع المجتمع العربي الاسلامي. ذلك على أمل أن مهمة حل التناقضات بين حركتي الحداثة والتقليد، والتي كانت ممكنة على أيدي المثقفين المسيحيين، ستتم عملياً بواسطة المثقفين الحداثويين المسلمين من خلال إطار الفكر الاسلامي. ذلك أنّ نقد العقل العربي على ايدي مثقفين مسلمين سيتسلّح بشرعية ضرورية في معارضة النزعة الاسلامية المحافظة.
ولكن إذا كان المعسكر المحافظ من تقليديين مسلمين ومحافظين، يحمل فرضيات وأهداف واضحة تجاه المجتمع الغربي وتجاه الغرب، بقيت صفوف المثقفين العلمانيين المسلمين مشتّتة وغامضة، لم يتكيّفوا بشكل منظّم مع الفكر الغربي. فكان نقاشهم مع الاسلاميين اعتذارياً تبريرياً يخفون علمانيتهم ويشدّدون على أنّهم ايضاً “مسلمين”. ويرى شرابي أنّهم “بدلاً من إعادة صياغة فرضياتهم بتعبيرات حديثة كما يحاول الاصلاحيون الرواد، اختاروا انتهاج أساليب التبرير التقليدية وطغت الدعاية والمماحكة على مقاربتهم للأمور بدلاً من النقد والتحليل” . وفي السنوات الأخيرة برز الهجوم السافر للأصوليين في مواجهة المسلمين العلمانيين في حلقات “توك شو” على الفضائيات العربية، كـ”الجزيرة”، حيث تتضح اليد العليا للأصوليين في الحوار واستحياء العلمانيين في الرد الصريح.
وكانت النتيجة في الفترة الممتدة من 1920 إلى 2000 أنّ لا المثقفين المسيحيين ناقشوا المقدّسات ولا المثقفين المسلمين، الذين إما تقاعسوا أو تعرّض مَن جروء منهم للأذى والنفي والقتل. ولعل النقاش بين المفكّر السوري جورج طرابيشي والمغربي محمد عابد الجابري هو مثال على هذه الخلاصة التي وضعها شرابي. وطرابيشي يأتي ضمن سلسلة العلمانيين العرب، مثال ميشال عفلق الذي درس الفلسفة في باريس وعاد بأفكار أوروبية لتأسيس حزب قومي علماني، وأنطون سعادة الذي كتب نصّاً أساسياً نشر جزءه الأول، نشوء الأمم، استند في أفكاره إلى مفكّرين غربيين ألمان وفرنسيين وبريطانيين، وهدف الابتعاد عن فكرة القومية العنصرية (كالنازية الألمانية) أو الدينية (كالأصولية الاسلامية)، واشتقاق قومية اجتماعية تتأسّس على خليط تاريخي معقّد لجماعة أقامت على نفس الأرض. ولكن ميشال عفلق وأنطون سعادة بقيا ضمن منهاج المثقفين المسيحيين في عدم التعرّض للنص المقدس (رغم مقاربة سعادة في الاسلام في رسالتيه). وهو ما فعله آخرون سبق ذكرهم. من هنا كانت مساهمة جورج طرابيشي في نقد العقل العربي تصبّ في تفكيك التراث و”نقد” المفكر المغربي محمّد عابد الجابري للعقل العربي .
الجابري صاحب هذه الأعمال الجليلة صمت دهراً عن نقد طرابيشي ثم نطق أخيراً وقال إنّ “طرابيشي مسيحي، ولا يحقُّ له الخوض في الإسلام”. وهي تهمة أشرنا إليها سابقاً أنّها كانت في أساس خوف المثقفين المسيحيين من خوض نقاش النص المقدّس والتراث الاسلامي لكي لا يتهموا بأّهم ضد الديانة الاسلامية. لقد فُجع طرابيشي بسطحيّة تعليق الجابري على نقده له رغم اعجابه وافتتانه بأعماله على مدى عقود. وما زاد الطين بلّة أن الجابري لم يكتفِ بذلك، بل كرّر قوله في مهرجان الجنادرية في السعودية حين صرَّح بأن “ثمة مناطق في الإسلام والثقافة العربية والإسلامية محظورة على المسيحي”. أسف طرابيشي أن ” يُخفض بعض المفكرين العرب سقف أفكارهم، ويتخلَّون عن جرأتهم بهدف كسب الجماهير”. رفض الجمهور المسلم الواسع والأصوليون كتابات طرابيشي ولم ترضى عنه السلطة السياسية العربية. ولكن طرابيشي وجد روح المتابعة وتعزّى في أنّ فكره وإن كان منفيّاً فهو ليس يتمياً بين المفكّرين العرب لأنّ ثمّة كثيرين يفكّرون مثله: “المفكر الحقيقي هو القادر على الإنجاب. ربما لا يُنجب في هذا الجيل، بل في جيل لاحق”. ويقول: “نحن نعيش حالة نتجت عن أمرين أساسيين: خيبة الجماهير بأنظمة سياسية وأيديولوجيات، والدولارات النفطية التي غزت كل مفاصل حياتنا”. بالنسبة إليه، الأصولية كانت نتيجة لكل هذا. “أعتقد أن معركتنا مع الأصولية تحتاج إلى مئة سنة، ولست متأكداً مِن هوية المنتصر” .
4-حياة وموت الثقافة العربية
وإذا كان طرابيشي انتقد الجابري في صلب التراث فإنّ أدونيس ذهب أبعد من ذلك واعتبر أنّ الجابري كان ناقلاً وحسب، لم يساعد في تأسيس فكر أو حلقة فكرية تنطلق من نقد المسلّمات ذاتها، أكانت دينية أو غير دينية، ولهذا السبب فهو يرى أن الجهد الضخم الذي قدّمه جورج طرابيشي جهد ضائع، “وليته وضع هذا الجهد في مكان آخر، في نقد المسلّمات ذاتها”. والمطلوب في نظر أدونيس تغذية المشروع النقدي الحقيقي في قراءة التراث، لا الانطلاق من المسلّمات القائمة في التراث ما لا يؤدي إلى فكر خلاق وحقيقي، إذ أنّ كل فكر حقيقي يجب أن ينطلق من نقد المسلّمات ذاتها ومن زلزلة هذه المسلّمات لبناء فكر عربي جديد. أمّا من يستحق التقدير في عمله على نقد المسلّمات، فأدونيس يسمّي المفكّر الجزائري محمد أركون والمفكّر المغربي عبدالله العروي. فأركون خاصة هو صاحب مشروع نقدي أكثر جديّة باعتباره يتناول النصوص التأسيسية في الفكر العربي، واقتراح العلمنة كحل للعرب بالاستفادة من التجربة التركية التي تحتاج بنظره إلى اهتمام فكري في نطاق الفكر العربي فلا يبقى العرب منعزلين عن التيار المرتبط بالحداثة العقلية . ويقول أدونيس:
“إنّ محاولة أركون تحتاج إلى المزيد من الجرأة والتوسّع والبناء على الأطروحة التي يقدّمها، وهو يعترف بذلك، وأنا ناقشته أكثر من مرّة، ولديه خشية من أن يؤدي ما يقوله إلى أن يدفع حياته ثمناً لذلك. وهو ليس مستعداً كما قال لي ليدفع هذا الثمن.. إنّ محاولة أركون التي تتلخّص في قراءة النص التأسيسي الأولي أي النص الديني، بوصفه نصّاً تاريخياً، خطوة مهمة جدّاً. وهذا ما حاوله مدارة، ومن غير المضي إلى نهايات هذه الأطروحة، نصر حامد ابو زيد” .
وتعكس الفقرة التالية رأي الأصوليين والسلفيين في تعامل العلمانيين مع الثقافة بمفهومها الكوني الواسع على أنّه تغرّب وابتعاد عن جذور الدين الاسلامي، وهو رأي لا يشكّل تحديّاً جديّاً للمثقف في البيئة العربية والاسلامية فحسب، بل يتضمّن التكفير والارتداد عن الدين وفي لبّه التحريض على القتل، كما تبيّن في العقود اللاحقة:
أدّت علمنة مفهوم الثقافة بنقل المضمون والمحتوى الغربي وفصل هذا المفهوم عن الجذر العربي والقرآني، إلى تفريغ الثقافة من الدين وفك الارتباط بينهما. وصار المثقف هو الشخص الذي يمتلك المعارف الحديثة ويطالع أدب وفكر وفلسفة الآخر، ولا يجذّر فكره بالضرورة في عقيدته الإسلامية إن لم يكن العكس تمامًا. ووُضع المثقف كرمز “تنويري” بالفهم الغربي في مواجهة عالم الدين. ففي حين يُنظر للأخير بأنه يرتبط بالماضي والتراث والنص المقدّس، ينظر للأول -المثقف- بأنه هو الذي ينظر للمستقبل ويتابع متغيرات الواقع ويحمل رسالة النهضة، وبذلك تم توظيف مفهوم الثقافة كأداة لتكريس الفكر العلماني بمفاهيم تبدوا إيجابية، ونعت الفكر الديني -ضمناً- بالعكس. وهو ما نراه واضحًا في استخدام كلمة الثقافة الشائع في المجال الفكري والأدبي في بلادنا العربية والإسلامية؛ وهو ما يتوافق مع نظرة علم الاجتماع وعلم الاجتماع الديني وعلم الأنثروبولوجيا إلى الدين باعتباره صناعة إنسانية وليس وحيا منزّلاً، وأنه مع التطور الإنساني والتنوير سيتم تجاوز الدين والخرافة. أما في المنظور الإسلامي فمثقف الأمة هو المُلمُّ بأصولها وتراثها. وعبر التاريخ حمل لواء الثقافة فقهاء الأمة وكان مثقفوها فقهاء. وهو ما يستلزم تحرير المفهوم مما تم تلبيسه به من منظور يمكن فيه معاداة الدين أو على أقل تقدير النظر إليه بتوجس كي تعود الثقافة في الاستخدام قرينة التنوير الإسلامي الحقيقي، وليس تنوير الغرب المعادي للإله، والذي أعلن على لسان نيتشه موت الإله فأدى فيما بعد الحداثة إلى موت المطلق وتشيّؤ الإنسان .
لقد وصل أدونيس إلى قناعة أنّ “مشروع الحداثة فشل بكامله في المجتمع العربي”. ويقول إنّ “أكبر دليل على فشله هو أننا أخذنا منجزات العقل الغربي ورفضنا مبادىء هذا العقل. وهذه مجرّد لعبة استهلاكية وأكبر احتقار لمعنى الحداثة.. إذا كان لدينا اليوم ظواهر فنيّة حديثة في الفن التشكيلي أو في الفن الروائي أو حتى في الفن الشعري، وإذا كان لدينا بروز فكرة جيدة فهي لا تعود إلى النمو الطبيعي للمجتمع وإلى تفتّح طبيعي من داخل المجتمع وحركة تطوّره، بقدر ما تعود إلى الانشقاقات التي جاءتنا خلال صلاتنا بالفكر الغربي”.
ويطرح أدونيس سؤالاً افتراضياً: لو انتزعنا من الثقافة العربية اليوم مؤثرات الفكر الغربي وجميع أشكال التأثير فماذا يبقى فيها وماذا يبقى منها؟
ويجيب بأنّه لا يبقى سوى الفكر الديني الأصولي المغلق، وأنّ على المثقف أن يقول هذا الكلام، لا أن يردّد كلاماً مهيناً للثقافة والانسان ويعتبر أي اقتباس أو انفتاح بأنّه غزو ثقافي. ويطالب أدونيس بحداثة ثانية، لأنّ الحداثة الأولى الفنية والشعرية (الخمسينات والستينات) قد أدّت مهمتها في إطارها التاريخي، وعلى العقل العربي أن يكون قادراً على ابتكار صيغ للتعببر عن المشكلات الراهنة.. ولكن هل هذا ممكن؟ هل هو ممكن في ظل سلطات تخاف الفكر مثلما تخاف الموت؟ لذلك تغلق المنافذ في وجه المفكرين وتمنعهم من القدرة على التفكير بحرية” .
والديمقراطية لوحدها لا تكفي. لأنّه “إذا لم يتيسّر للديمقراطية وللعلمانية عقول كبيرة وأخلاق وممارسات كبيرة وتربية راقية، تتحوّل إلى مجرّد ألفاظ”. ولكن لا غنى عن الديمقراطية والعلمانية لولادة الفكر والأخلاق.
ورغم إنّ أدونيس يعود مراراً إلى الأمل، إلا أنّ تشخيصه للواقع العربي ينضح عن وضع ميؤوس، إذ أنّ احتمال التغيير ضئيل جداً أمام قوّة السلطة التي لا تُقهر. المشلكة الأساس إذاً هي “السلطة وبنية السلطة عند العرب. وما لم تتغيّر هذه البنية من المحال أن نتقدّم. لأنّ السلطة صارت مجتمعاً منفصلاً داخل هذا المجتمع العريض، مثل قلعة مطوّقة ومسوّرة من جميع الجهات، وهي تملك المجتمع الذي تهيمن عليه بالكامل. فهي إذن تشلّ المجتمع وتمنعه من أن يشارك في بناء السياسة التي هي مسؤوليته. المجتمع وأفراده لا رأي لهم في اي شيء. والشعب معزول عن المشاركة في بناء مصيره وحضاره ومستقبله. وهذا العزل الذي تمارسه السلطة العربية منذ قرون هو أساس تخلّفنا” .
ويشرح أدونيس لماذا يحتاج العرب إلى إعادة قرءة تراثهم، بأنّ الشعوب العربية خلال 1400 سنة متواصلة استندت في نظرتها إلى العالم وفي مقاربتها الأشياء وفي علاقاتها بالآخر إلى مفهومات راسخة ومستمدّة من فهم معيّن للإسلام الذي هو أساس حياتها وثقافتها، ها هي تجابه اليوم أوضاعاً جديدة وثقافات مختلفة وتطورات محيّرة، فما عادت قادرة على فهم العالم المعاصر بالمفهومات الموروثة مهما كانت. والحل عند أدونيس لفهم العالم المعاصر هو رؤية جديدة ومفهومات جديدة تنبثق من إعادة نظر جذرية للثقافة الاسلامية “وإلاّ نحن ذاهبون إلى الكارثة.. من المحال أن نفهم القرن الحادي والعشرين بنظرة ترسّخت في القرن الأول الهجري. نحن نمشي مقيّدين نفكّر والسلاسل في رؤوسنا وفي أعناقنا. وعلى الرغم من ذلك ما زال بعضهم يلوك نظرة متطرّفة تدّعي أنّ في الاسلام حلاًَ لكل شيء ونظرة متطرّفة تواجهها أنّ الاسلام سبب كل تخلّف. لماذا هذا التضارب والتطرّف؟ لأنّ حرية النقاش والتعبير والتفكير غير موجودة” . أولئك الذين يتهمون الاسلام بأنّه أساس التخلّف لا يعترفون، حسب أدونيس، أنّه كان في عهد العباسيين وسيلة للتقدّم. فتأويل النص هو مفتاح الفهم، وليس التعصّب للدين أو معاداة الدين، العقل عند أدونيس هو قبل الدين، والدين هو تابع للعقل وليس العكس.
ويلفت أدونيس النظر إلى طغيان الحركات الظلامية عند العرب وتراجع العلمانيين والمتنوّرين: إنّه لشيء مخيف في آخر القرن العشرين (وبداية القرن الحادي والعشرين) أن تكون الفئة الوحيدة التي تمتلك الحرية الكاملة في التعبير عن آرائها هي الفئات الظلامية، لها الحق في التعبير عن فكرها بحريّة تامة، منابرها موجودة في المساجد وفي المجلات والجرائد والأموال ووسائل الاتصال وحرية الاجتماع والدعوة، والجمهور جاهز والايديولوجيا حاضرة، وتمتلك كافة مقومات الأحزاب. “الأصولية بالمعنى السائد خطِرة جداً، وهي حركة آلية عمياء لا ترى إلا حركتها هي وتلغي ما عداها. وهذا من أخطر ما يجابهنا”. إنّها معطّلة للمجتمع ولكل مظاهر الحياة ومؤذية مارست القتل، من حسين مروّة ومهدي عامل (في لبنان) إلى فرج فودة في مصر، وحاولت قتل نجيب محفوظ ونفت نصر حامد أبو زيد، فضلاً عن عشرات الضحايا في الجزائر ومصر وغيرها من البلدان العربية .
فيما سار العالم المسيحي في طريق التغيير والتحرّر وإخراج النص الديني من الشعوذة، بدءاً من القرن السادس عشر مع الاصلاحيين البروتستانت ورواد عصر النهضة الأوروبية في فرنسا وألمانيا وإيطاليا، بقي العالم العربي على حاله خلال 1400 سنة حتى اليوم، حيث انتقت السلطة الزمنية والدينية في دنيا العرب والاسلام ما يناسبها من أفكار وطروحات لتستمرّ في هيمنتها، وأهملت ما يعارض هذه الهيمنة، بما فيها تفسيرات أخرى للنص ومفاهيم الله والخلق. ويعجب أدونيس كيف أنّ اليهودية، كدين بدائي رعوي، أتاحت لأتباعها أن يقيموا نوعاً من التوازن بينها وبين العلمانية ونوعاً من الديموقراطية فيما بينهم، وأن يتحاور مجتمعهم دون أن يتقاتلوا، وأنّ عدداً كبيراً من مثقفي اليهود يسخرون من قصص التوراة وحكايات الأنبياء. بينما الاسلام العريق والأرقى دينياً من اليهودية لم يستطع أن يفعل ذلك قط، وكيف أنّ المسيحية أيضاً استطاعت بعد ثورات عنيفة وحروب دموية أن تتوسّل إلى مثل هذه المجتمعات في أوروبا أمّا الاسلام فما زال بعد 1400 سنة يكرّر نفسه وما فتيء ينتج السلطة ايّاها التي أُسست بل 14 قرناً.
“الاسلام السائد نفسه ليس فيه فكر. إذا تناولنا الإسلام اليوم بوصفه فكراً فلن نجد فيه مفكّراً واحداً ذا قيمة. فإن وُجد مفكّر ما له بعض الحضور، فإنّ فكره لا يعدو كونه نوعاً من إعادة كتابة لكتابة الفقهاء القدامى. ليس هناك فكر إسلامي جديد اليوم على الإطلاق. وهذا ينطبق على القرن العشرين كلّه. فمع أنّ الكلام على الإسلام لا يتوقّف، فهناك كلام كثير على الصحوة الاسلامية والنهضة الاسلامية والفكر الاسلامي، لكن لا فكرة جديدة حيّة، إنسانياً وعقلياً، أضيفت إلى ما قاله المسلمون القدامى. كل شيء تحوّل إلى طقوس وإلى شرع. الموجود الوحيد هو القانون والشرع. ولكن هذا شيء والفكر شيء آخر. ويبدو الاسلام كما يُمارس اليوم ومعه الأديان الأخرى في هذه المنطقة (المسيحية واليهودية) خارج الفكر وخارج العقل لكنّه داخل الطقوس والعبادات والتشريعات”.
ولا يوافق أدونيس أنّ عهود الاسلام كانت كلّها نور ومعرفة وأنّ ما قبلها وما عداها هو الجهل والظلام. بل أنّ الاسلام قدّس لغة الجاهلية وأدَبَها واعتبرها المقياس، واختار ايضاً ما يناسبه من أساطير وأهمل أخرى. لذلك أشرف أدونيس على “ديوان الأسلاطير” بعدّة أجزاء يشتمل جميع النصوص القديمة التي ظهرت قبل الأديان في الشرق الأوسط، وتحديداً في العراق ومصر. ويقول أدونيس لصقر أبو فخر: “أنت تعرف تماماً لماذا يرفض الاسلام هذه النصوص القديمة. إنّه يرفضها باسم الوثنية تارة وباسم الخرافة والسحر تارة أخرى. لكن من المستغرب أن يتبنّى القرآن كثيراً من هذه الخرافات ولا سيما المتعلّقة باليهود مثل عصا موسى والطوفان وانشقاق البحر.. إنّ في الموروث الاسلامي، على الرغم من أنّ الاسلام نَقَد الأسطورية والفكر الأسطوري، كثيراً من الأساطير. وأعتقد أنّ الفكر الإسلامي السائد اليوم هو، في شكله الأصولي، فكر اسطوري، لكنّه فكر أسطوري “مُشرعن”. أي أنّ الشعر والشفافية الموجودة في الأسطورة القديمة افتقدها هذا الفكر وصار أسطورة مشرعنة اتخذت طابع القانون. وهذا جمّد حركية الفكر الاسلامي وجمّد المخيلة الاسلامية. وأنا أعتقد أنّ الفلاسفة والمفكّرين المختصّين يجب أن يدرسوا الفكر السائد الأصولي بوصفه فكراً أسطورياً مشرعناً”.
درس باحثون بعض الأساطير ورأوا أن القصص القرآني ليس سرداً لوقائع تاريخية بل حكايات ورموز وعِبَر تهدف إلى الوعظة والفكرة الإخلاقية، ويذكر أمثلة من النص الديني بأنّ الكون قد خُلق في ستة أيام وتفاحة حواء وآدم وطوفان نوح وتوقف الشمس بأمر يشوع بن نون والأيام الثلاثة التي أمضاها النبي يونس في بطن الحوت والإسراء والمعراج وشق القمر نصفين، وهي كلها قصص كانت منتشرة في نصوص ما قبل الاسلام. ويضيف أدونيس أنّ كثيراً من نصوص التوراة هي كتابة جديدة لعدد من اللأساطير القديمة، اقتبست مثلاً من بلاد ما بين النهرين . “قصص التكوين وسِفر أيوب وسِفر إرميا ونشيد الإناشيد، كلّها مستمدّة من نصوص سابقة. لكن القرآن استعاد كثيراً من هذه الأساطير الواردة في التوراة. بينما المسيحية نبذتها كلّياً ولم تستعن إلا باسطورة واحدة هي أسطورة “تمّوز” أي الموت والانبعاث”.
ولكن ماذا عن الحضور المسيحي الثقافي في الشرق؟
“المسيحية تكاد أن تكون مهمّشة ولا وجود لها في المضمار الفكري الثقافي. حتى أنّ الكنيسة داخل المجتمع الاسلامي تأسلمت بمعنى أو بآخر. ولهذا ليس للمسيحية المشرقية حضور فكري، لأنّها، في تقديري، أسلمت منذ زمن طويل، اي أنّها اتخذت طابع المجتمع الاسلامي وصارت مجرّد شعائر وطقوس دينية”.
مع أزدياد الكلام عن العولمة تصاعدت أصوات في العالم العربي تخشى فقدان الهوية بحجّة التغرّب، فيما ندّدت جماعات خرجت من عباءة السلفية بما يسمى بالغزو الثقافي. ويرى أدونيس أنّ “التغرّب والغزو الثقافي عبارتان لا علاقة لهما بالثقافة. عبارتان سياسيتان إيديولوجيتان.. ليس هناك في حياتنا اليومية والعملية وفي عاداتنا ولباسنا ومأكلنا وبيوتنا ووسائل المواصلات لدينا إلا ما هو غربي. كل شيء آت من الغرب. إذا كان تغرّباً أن تقرأ فرويد أو ماركس، فلا أعرف كيف يتكلّمون على الغرب والغزو الثقافي”. وهذا الكلام يافطة تُلهي الناس عن التفكير في مصيرهم الداخلي الحقيقي بحجة وجود عدو خارجي، وللتمويه على المفاسد داخل المجتمع. “ثم أنّ الهوية كلما احتكّت بالآخر كلما نَمَت”، هي ليست محتجزة داخل صندوق يمنع تسرّب الهواء والشمس إليها. “العولمة تكشف عن ضحالة المُنجز العربي سياسياً وثقافياً واقتصادياً. وهي ضحالة سببها الأنظمة في الدرجة الأولى, لذلك نرى مثقفو الأنظمة يتباكون رعباً من العولمة بذريعة الخوف على الهوية والسؤال الحقيقي هو ماذا فعل هؤلاء المثقفون وأنظمتهم لإغناء هذه الهوية؟ العولمة لا يمكن أن تطمس المعرّي وابن عربي وابن سينا والفارابي وابن خلدون والمتنبي. إنّها لا تطمس الاختلاف والخلق بل تطمس مَن ليس له حضور خلّاق”.
خلال عقود من عمله الفكري تعرّض أدونيس لهجوم من جميع الجهات، أولاً بسبب لاإنتمائه السياسي لأي نظام عربي، فهو يركّز على مشروع ثقافي حضاري أبعد من السياسة. فيهاجمه مثقفون ارتبطوا بالانظمة لتغطية توّرطهم هم. ثم أنّ كثراً هاجموه بأنّه “قومي سوري أو ناصري أو شيوعي وماركسي وصولاً حتى إلى تهمة الوهابية”. وتأكّد له مراراً أنّه لو كان من طائفة غير الطائفة التي ولد فيها لما تقاطر عليه هذا الهجوم. “لقد وصل الانحطاط إلى مستوى متدنٍ جدّاً حتى في مناخ الصراع الفكري والسياسي.. والانسان بمشروعه لا بولادته. هو بما يقوله ويعبّر عنه، لا بانتمائه إلى هذه الطائفة أو تلك.. فالمثقفون العرب لا يفهمون معنى أن يكون الانسان مستقلاً.. إنّ ما يمكنهم تصوّره هو أن الفرد يجب أن يكون تابعاً أو مرتبطاً بشكل أو بآخر. هناك انعدام كامل بالثقة لدى العرب ولا سيما المثقفون منهم. لذلك عاش المثقفون العرب في ريبة من الفرد المستقل. كل واحد يشك في الآخر لأنّه يعتقد أنّ الآخر مثله يجب أن يكون مرتبطاً. هذا فكر مريض لأشخاص مرضى حقيقة” .
ويشعر أدونيس بكثير من الأسى حول مسألة تقدّم الغير ومراوحة العرب مكانهم: “عندما أقارن ما ينجزه العالم بما ننجزه نحن شعرياً وروائياً وتقنيّاً، يكاد الانسان يخجل من إنتمائه إلى العالم العربي. ثم حين أقرأ الحوارات العقلية أو الفكرية والآراء والنقاشات والسجالات والتطلعات والهموم التي تسود حركة المجتمعات في هذا العصر، ثم أنظر إلى ما يسود مجتمعنا، أشعر بالأسي العميق لأنّ أكثر ما يهم العربي ويشغله هو شرف المرأة، وليس في عظمتها وكيانها وحريّتها، بل في أمور الجنس، حتى سيطرت أفكار الحلال والحرام على كل شيء. إنّها هموم صغيرة تقزّم الانسان وتقزّم العالم حتى بات الواحد يخجل من الانتماء إلى مثل هذه الثقافة”.
ولكن كي لا يظنّ المرء أنّ أدونيس مشدوه ومسحور بالغرب وتكنولوجيته فهو ليس كذلك، بل يرى أنّ ثمّة تواصلاً بين الثقافة والتكنولوجيا، وأنّ تكنولوجية الغرب إذا لم ترتكز إلى الأخلاق فهي لا تجعله متمدّناً: “أنا لا أعتقد أنّ من يقود الطائرة ليقصف هيروشيما أو أي قرية أخرى أكثر حداثة بالمعنى الانساني من فلاح بسيط في العراق يحرث حقله يوميّاً”. وبهذا بقي أدونيس الوريث المخلص لوصايا إدوارد سعيد لواجبات المثقف ولمواصفات هشام شرابي للمثقف العربي العلماني.
تجليات الموت الثقافي
منذ سنوات بعيدة والشاعر أدونيس يعلن زوال العرب كحضارة ويقصد غياب دورهم كقّوة اقليمية ثقافية اقتصادية عسكرية وسياسية موجودة في الجغرافية، ازاء صعود دول اقليمية غير عربية لملأ الفراغ (إيران واسرائيل وتركيا). وكان ثمّة من يردّ على أدونيس بأنّ هناك أملاً بعودة العرب واحتمالات نهوضهم ومواجهتهم للتحديات. وعندما انطلقت الانتفاضات الشعبية في معظم الدول العربية في مطلع 2011 رأى فيها المتفاءلون إحياءً جديداً للقومية العربية والعمل العربي المشترك المفتقد منذ 1973 على الأقل. ولكنّ الأحداث تدعو المراقب إلى التروّي في استخلاص نتائج هذه الانتفاضات. ومن الدروس الأولية أنّ الصراع الحقيقي في المنطقة هو على مستوى دولي أعلى وما العرب سوى لاعب جانبي أو على الأقل ليسوا لاعباً رئيسياً. فعلم فلسطين لم يرتفع وشعارات العروبة لم تتصاعد الفراغ الجيو بوليتكي في الساحة العربية تملؤه فعلاً اسرائيل وإيران وتركيا.
مراجعة سريعة لتحديد المقصود بـ”موت العرب” ستفيد نقاشنا هنا. ذلك أنّ البلدان العربية كانت ولمّدة أربعمائة عام ولايات ضمن السلطنة العثمانية المتعدّدة الإثنيات والديانات. إلى أن جاءت بريطانيا وفرنسا منذ بداية القرن التاسع عشر وأحيت العنصر العربي كعامل تفكيكي للسلطنة، حتى سقطت المنطقة عسكرياً بأيدي الحلفاء بعد الحرب العالمية الأولى وسعت بريطانيا إلى ولادة كيانات عربية. ثم برزت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ثلاث دول محورية عربية هي مصر والسعودية والعراق كانت النواة التي اجتمعت حولها الدول العربية الأصغر. فأصبح العالم العربي منطقة جغرافية معروفة ونشأت جامعة الدول العربية بمسعى بريطاني عام 1944. وفي الخمسينات والستينات ارتفعت القومية العربية مع حزب البعث وحركة القوميين العرب وظاهرة الزعيم المصري جمال عبدالناصر، لتصبح العروبة هوية جامعة لأكثر من 20 دولة.
أولاً، اسرائيل تقضي على القومية العربية
لم يستمر صعود المنطقة العربية طويلاً إذ أنّ بريطانيا زرعت في وسطها دولة اسرائيل التي كان لعدوانها منذ 1948 الدور الأول والأكبر في بدء زوال العرب ككتلة بشرية وجغرافية. لقد هزمت اسرائيل العرب عام 1967 ما أدّى إلى نهاية القومية العربية الحداثوية. وعندها بدأ أدونيس مع كثيرين من جيله مراجعة شاملة لحقبة العروبة ومثالياتها التي أوصلت العرب إلى الطريق المسدود. ثم عاد الأمل مع حرب تشرين الأول 1973، التي كان من نتائجها صعود سورية كدولة محورية عربية رابعة. ولكن الاحباط عاد مع دخول مصر في نفق كامب دافيد ومع اجتياح اسرائيل للبنان في 1978 و1982. وكان المثقفون والعقائديون العرب يعتقدون أنّ صعود المقاومة الفلسطينية بعد هزيمة 1967 سيرّد الكرامة العربية ويعوّض عن الهزيمة. ولكنّه كان صعوداً مبتوراً وقصيراً سرعان ما غرق في حروب أهلية في الأردن ولبنان. وعام 1974 حلّ مكان الأنظمة والحركات العروبية والثورية، بنظر أدونيس، المحافظون العرب بثرواتهم وعودتهم إلى عروبة تقليدية سنيّة قمعت العروبة العلمانية وطردتها من وسطها وسعت لهزيمتها أمام اسرائيل عام 1967.
ثانياً، ثورة ايران شرارة الحرب الأهلية داخل الاسلام
ثم جاء الدور الثاني لإيران في محو الكتلة العربية. فقد اطاحت ثورتها عام 1979 بالشاه وسرعان ما سعت كما فعل ثوار روسيا وفرنسا سابقاً، إلى نشر ثورتها في الدول العربية. ليبدأ صراع داخل الاسلام بين نظام اسلامي تقليدي الذي تمثّله أنظمة سنيّة عربية كبرى كالسعودية ومصر السادات والعراق، ونظام إسلامي ثوري ثمثّله ايران الشيعية بامتداداتها في العالم العربي وآسيا. فساهم التحدي الإيراني في صعود إسلام أصولي مسلّح يشنّ حرباً ضروس ملأت الثمانينات والتسعينات من القرن العشرين تاركاً صرح العروبة أشلاء ممزقة. فأخذ المثقفون ينعون العرب والعروبة، وتكلّم نزار قباني عن “موت العرب” (مثلاً في قصيدة بلقيس) وأعلن أدونيس “وفاة الحضارة العربية”. وكان من ملامح فيضان ثورة إيران سهولة تدخّلها في عمق القضايا العربية لتصبح هي، لا العرب، حاملة مشعل فلسطين – قضيّة العرب الأولى – ومدافعة عن قضايا المهمّشين والأقليات في العالم العربي (الشيعة في العراق والجزيرة العربية ولبنان). وكان خطر إيران على النظام العربي أنّها عرّته من إدّعاء العروبة، وكشفت أنّ عروبته لم تكن سوى غطاءً للاسلام السنّي التقليدي. وعبّر أدونيس عن تعاطفه مع الثورة الايرانية التي أمل أن يأتي التغيير عن طريقها، فوضعه هذا الموقف في حالة خصام مع زملاء وأصدقاء اعتبروه منهم. واتهمه صادق جلال العظم أنّه وقع في سحر الخميني وأنّ أدونيس العصري العلماني فعل ذلك من اليأس ومن رومنطيقية تحنّ إلى العصب الديني. واتهم آخرون أدونيس بالعودة إلى المذهبية والعداء للعروبة، وأنّ تعاطفه مع إيران الشيعية هو دعوة “الأقلوية العلوية” التي أتى منها.
لم يعر أدونيس كثير انتباه إلى نقّاده. فلم يشر مثلاً إلى أنّ اليسار العربي برمّته تفاءل بثورة إيران وأنّ الاتحاد السوفياتي والشيوعيين العرب رأوا في الجمهورية الاسلامية انتصاراً لشعوب العالم الثالث ضد الامبريالية، وأنّ أول خطوة لإيران كانت إقفال سفارة اسرائيل في طهران. بل اتهم أدونيس نقّاده أنّهم لا ينظرون إلى البنية الاجتماعية والفكرية المهترئة التي يعيشون فيها في العالم العربي والتي اصبحت قاحلة في ظل القمع والاضطهاد، وأنّ مجتمعهم بات أرضاً جرداء تأثيرهم فيها هو صفر. وأنّ العرب تكلّموا عن الوحدة العربية منذ خمسين عاماً ولكنّهم بقيوا مفرّقين مشتتين وفي عداء دائم فيما بينهم. وأنّ التقبّل السطحي للعلمانية في الأنظمة الجمهورية كان رياءً أخفى ولاءات طائفية حتى في الدول التي ادّعت التقدمية. وأنّ تجربتهم في الاشتراكية العربية كانت في حقيقتها هيمنة أفراد وعائلات الحزب الحاكم أو العائلة الحاكمة للاثراء والفساد ونهب البلاد لمصلحتهم الشخصية. وحتى الأدباء والمثقفين باتوا كتبة وموظفين لدى الأنظمة الرجعية. ولكن أدونيس لم يكن متأكّداً أنّ ثورة إيران ستنجح في تغيير الواقع العربي والاسلامي نحو الأفضل. فقد تتغيّر الشعارات ويتغيّر الخطاب الرسمي ولكن العبرة بالنسبة لأدونيس كانت في ما يجنيه الشعب وقضية الحريّة والعدالة.
اعتبر أدونيس أنّ ما يحصل في الشرق الأوسط منذ 1979 هو حرب أهلية داخل الاسلام بين إيران الشيعية والعرب السنّة الذين هالهم أن تكشف إيران عوراتهم في أنّ عروبتهم كانت غلافاً يخفي تخلّف وبداوة قبلية وطائفية مذهبية واثنيات غاضبة وصراعات عائلية وقمع للمرأة. لقد كانت مواجهة إيران الأولى مع العروبة السنيّة دموياً عندما اختار النظام العربي العراق – وليس مصر الضعيفة ضحية اسرائيل – للقضاء على إيران الثورية. فشنّ صدّام حسين تحت لواء العروبة الحرب على “الفرس – المجوس”. واستمرّت الحرب الأهلية داخل الاسلام حتى انكسر العراق وانتشر النفوذ الايراني في المشرق العربي. ومن نتائج الحرب الأهلية في الاسلام سقوط العراق تحت الاحتلال الأميركي عام 2003 حيث ظهر النفور والتباعد بين السنّة والشيعة. كما ظهر هذا النفور في لبنان تحت مسميّات 8 و14 آذار، وفي فلسطين بين “فتح” و”حماس” وعبر حركات أصغر في بلدان عربية أخرى.
ثالثاً، تركيا تتسلّم قيادة عرب السنّة؟
لم يستشرف أدونيس صعود تركيا، الدولة غير العربية، بعد سقوط مصر والعراق. فقد ولّد غياب أي قوّة عربية جدية قي وجه إيران فراغاً سمح بصعود تركيا التي أخذت دور رأس الحربة السنيّة في المنطقة. فادّعت إعلامياً فقط نصرة فلسطين لأنّ ذلك يجلب عاطفة الشارع العربي، ولكنّها حافظت على علاقات وثيقة مع اسرائيل واميركا واكتفت بالمواقف الكلامية في الاعلام والمؤتمرات والتظاهر بالغضب الذي لم يرافقه أي إجراء عملي من مقتل9 أتراك على أيدي جيش اسرائيل في بحر غزّة صيف 2010، رغم أنّ الفلسطينيين يُقتلون بالمئات والألوف منذ 60 عاماً.
لقد أقنعت تركيا أميركا والغرب أنّ باستطاعتها تزعّم “حركة اعتدال اسلامي” كتلك التي سيطرت على تركيا تحت مسميّات الرفاه والعدالة والنهضة منذ التسعينات. وهو اعتدال يشمل مهادنة اسرائيل وتبادل السفارات معها. ولئن كانت ممالك وإمارات العرب في الجزيرة العربية والخليج إسلامية محافظة تقف تحت لواء واشنطن وتحارب ضد إيران منذ 1979، فقد تركّزت انتفاضات 2011 على الأنظمة الجمهورية التي ترتدي غشاءً علمانياً في تونس ومصر وليبيا واليمن وسورية والجزائر. وكانت تركيا في طليعة الضاغطين لتغيير هذه الأنظمة. وأصبحت أنقرة محطة للإسلاميين السنّة وبعض الزعماء العرب السنّة المعتدلين ومنهم سعوديون ولبنانيون ومركزاً للمعارضين السوريين.
لقد أصبح أي دعم لقضية فلسطين في تظاهرات 2011 وكأنّه تهمة جاهزة بالإيرانية. وتواصل تقلّص النظام العربي مع زوال وتفكيك الدول المحورية العربية الواحدة بعد الأخرى وتقسيم السودان والعراق وربما ليبيا واليمن وسورية. وعلى هذا المنحى أن يتوقف وإلا على الجميع التسليم جدلاً بمقولة أدونيس عن موت العرب كحضارة وكتكتّل جيوسياسي فعّال.
[1] Hisham Sharabi, Arab Intellectuals and the West: The Formative years 1875-1914, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1970.[1] Edward Said, Representations of the Intellectual, New York, Pantheon Books, 1994.
[1] إدوارد سعيد، صُور المثقّف، بيروت، دار النهار، 1996، ص 22-24.
[1] إدوارد سعيد، صُور المثقف، ص 94.
[1] Edward Said, Culture and Imperialism, New York, Alfred Knopf, 1993, pp. 169-190.
[1] إدوار سعيد، صور المثقّف، ص 98-99.
[1] فخري صالح، ادوارد سعيد دراسة وترجمات، بيروت، منشورات الاختلاف، 2009.
[1] هشام شرابي، المثقفون العرب والغرب، ص 16-17.
[1] هشام شرابي، المثقفون العرب والغرب، ص 19.
[1] كحزب الاتحاد اللبناني الذي أسّسه يوسف السودا وآخرون في مصر.
[1] هشلم شرابي، المثقفون العرب والغرب، ص 21-22.
[1] هشام شرابي، المثقفون العرب والغرب، ص 30.
[1] هشام شرابي، المثقفون العرب والغرب، ص 30.
[1] هشام شرابي، المثقفون العرب والغرب، ص 24.
[1] محمد عابد الجابري (وُلد 1935) مفكّر مغربي، استاذ الفكر والفسلفة في جامعة الرباط، من مؤلفاته نحن والتراث (1980) والخطاب العربي المعاصر (1982) وتكوين العقل العربي (دار الطليعة، بيروت، 1984) وبنية العقل العربي (1986) والعقل السياسي العربي (1990).
[1] في النقد الأدبي كتب طرابيشي الله في رحلة نجيب محفوظ الرمزية والرجولة وأيديولوجيا الرجولة في الرواية العربية وشرق وغرب: رجولة وأنوثة.
[1] حسين بن حمزة، مقابلة مع جورج طرابيشي، جريدة الأخبار، 20 أيار 2009.
[1] التراث وتحديات العصر، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ص 156.
[1] صقر أبو فخر، حوار مع أدونيس، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2000، ص 111-113.
[1] صقر أبو فخر، حوار مع أدونيس، ص 91-92.
[1] صقر أبو فخر، حوار مع أدونيس، ص 116.
[1] صقر أبو فخر، حوار مع أدونيس، ص 118.
[1] صقر أبو فخر، حوار مع أدونيس، ص 136.
[1] صقر أبو فخر، حوار مع أدونيس، ص 141-142.
[1] صقر ابو فخر، حوار مع أدونيس، ص 98-99.