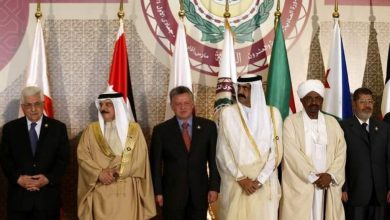الأمن عقدة المصالحة
الأمن عقدة المصالحة
نقولا ناصر
برعاية مصرية، اتفق مجددا في القاهرة يوم الأربعاء الماضي “على البدء الفوري في تنفيذ آليات الاتفاقات السابق توقيعها” بين حركتي “حماس” و”فتح”، وبخاصة “اتفاق الوفاق الوطني” الموقع في العاصمة المصرية في الرابع من الشهر الخامس عام 2011، وعدا “دعوة لجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية” للاجتماع في الأسبوع الأول من شباط المقبل “للاتفاق على الجدول الزمني لتنفيذ القضايا كافة في إطار رزمة واحدة وبشكل متواز”، لم يرد أي ذكر لهذه “القضايا” مثار الخلاف، مثل الانتخابات وتأليف حكومة وطنية .. والتنسيق الأمني مع دولة الاحتلال.
لكن الراعي المصري وطرفي الاتفاق الجديد وكذلك “كافة الفصائل الفلسطينية” التي اتفق أيضًا على دعوتها “خلال الأيام القادمة” كانوا وما زالوا يتجنبون أي إشارة علنية إلى أن الاتفاق أو الخلاف على “الأمن” كان وسوف يظل عقدة المصالحة التي تقرر نجاحها أو فشلها.
في الأقل لأن أجهزة أمن السلطة كانت ثمرة لاتفاقيات أوسلو التي لم تكن مشروعًا وطنيًا فلسطينيًا جماعيًا بقدر ما كانت مشروعًا لحركة “فتح” وحدها، لذلك كان العمل فيها احتكارًا لكوادر الحركة يقتصر عليهم وعلى أنصارهم بصفة رئيسة، والمفارقة اليوم أن “فتح” تأخذ على “حماس” الاقتداء بنهج مماثل في قطاع غزة.
ومن دون الاتفاق على الأمن سوف تظل محادثات المصالحة مضيعة للوقت، ومسلسلاً لا نهاية له ينتج بين وقت وآخر اتفاقيات محكوم عليها باستحالة التنفيذ، خصوصًا إذا اقتصرت على بحث “الإصلاح الأمني” فقط في قطاع غزة، حيث لا تنسيق أمنيًا مع الاحتلال ضد أي فلسطيني بينما يستمر التنسيق الأمني مع الاحتلال ضد المقاومة في الضفة الغربية، وهو تنسيق شهد، على سبيل المثال، ما لا يقل عن (247) اجتماعًا بين ضباط الجانبين خلال عام واحد في سنة 2008.
والتنسيق الأمني جزء لا يتجزأ من وجود السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية بموجب الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير وبين دولة الاحتلال، من دون أن يغير في هذا الواقع شيئا، في الأقل حتى الآن، اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بدولة فلسطين عضوًا مراقبًا غير عضو فيها، بديلًا للسلطة، وهو ما يمثل عقدة الخلاف الأساسية التي لا تزال تؤجل تنفيذ المصالحة الوطنية من اتفاق موقع عليها إلى آخر.
ولا جدال في أن دولة الاحتلال لن تسمح باستمرار وجود سلطة أو دولة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بالاتفاق معها، في حال توقف التنسيق الأمني بين الجانبين، وفي هذا السياق تأتي إنذارات الرئيس محمود عباس الأخيرة بأنه لن يسمح بأي انتفاضة أو مقاومة “مسلحة” للاحتلال الذي شن ثلاثة حروب مسلحة حتى الأسنان خلال عشر سنوات على مناطق السلطة الفلسطينية، في الضفة الغربية عام 2002، وفي قطاع غزة عامي 2008 و2012، وفي هذا السياق أيضا أصدر عباس تعليماته يوم السبت الماضي بعد اجتماعه مع قادة الأجهزة الأمنية بـ”ردع أي محاولة للمساس بالنظام العام أو إعادة مظاهر الفوضى والفلتان الأمني”، وهو مساس ومظاهر لم تصدر عن الشعب الفلسطيني إلا ضد الاحتلال ودولته وقواته ونظامه فقط، وهو ما يثير مجددا جدلًا فلسطينيًا ساخنًا حول دور قوى أمن السلطة – الدولة وعقيدتها القتالية.. وحجمها.
لقد حظيت بتغطية إعلامية واسعة نتائج دراسة حديثة لمعهد الدراسات والبحوث الاقتصادية “ماس” عن حصة الأجهزة الأمنية من الميزانية العامة التي بلغت (31%) من الناتج المحلي الفلسطيني لعام 2011 مقابل (11%) للصحة و(19.4%) للتربية والتعليم، ونسبة مئوية ضئيلة للزراعة، وبلغ عديدها في ذات العام حوالي (65) ألفا مقابل حوالي (88) ألف موظف مدني ليزيد عدد العاملين فيها على عدد العاملين في الصحة والتربية والتعليم والشؤون الاجتماعية مجتمعين، لتكون نسبة عدد قوى الأمن الفلسطينية إلى عدد السكان هي الأعلى بين مثيلاتها في العالم كافة.
لكن التغطية الإعلامية ربطت نتائج هذه الدراسة بالأزمة المالية التي تهدد بانهيار السلطة أكثر مما ربطتها بالمسوغات الوطنية لوجود أجهزة أمنية بهذا الحجم، وبدورها في حماية الأمن للسلطة والوطن والمواطن الذين لا حرمة لأمنهم في ظل الاحتلال الذي ينتهك أمنهم الوطني والشخصي ليل نهار من دون أي رادع، ليصبح التساؤل الشعبي مشروعًا عن جدوى وجود قوى الأمن الوطني والأمن الوقائي والمخابرات العامة والاستخبارات العسكرية وحرس الرئاسة وشرطة الجمارك والشرطة المدنية وقوة أمن الجامعات، إضافة إلى قوى بحرية وجوية ودفاع مدني إذا كانت جميعها لا تستطيع منع الاحتلال من اعتقال أحد المواطنين أو مداهمة مؤسسة فلسطينية واحدة، أو لا تستطيع حتى منع اعتقال 200 من كوادرها خلال الشهور الأخيرة، كما قال الطيب عبد الرحيم أمين عام الرئاسة للأسوشيتدبرس في الثاني من هذا الشهر.
ولتصبح مشروعة كذلك المطالبة بأن يتحدد حجم الأجهزة الأمنية وحجم حصتها من الموازنة العامة حسب حجم دورها في حماية أمن الوطن والمواطن، وحسب مدى تنسيقها الأمني مع الاحتلال، فلا يعقل أن يمول هذا التنسيق من جيوب المواطنين أو من أموال المانحين المقدمة لهم، ليستخدم هذا التمويل ضدهم وهم في أمس الحاجة إليه، فحسب دراسة “ماس”، استهلك الإنفاق على الأمن والنظام العام أكثر من ثلاثة آلاف مليار شيقل من موازنة عام 2011 حتى الشهر العاشر، بينما استهلكت رواتب الموظفين مليارين وثلث المليار شيقل في الفترة ذاتها.
والاستنتاج المنطقي واضح: إذ طالما أن الاحتلال قائم فإن الأمن هو مسؤولية الاحتلال وهو الذي يجب أن يكون مسؤولًا عن تمويله، وحصة الأمن من الموازنة العامة أكثر من كافية لدفع رواتب الموظفين بانتظام، من دون حاجة لـ”شبكة الأمان” العربية المالية التي سوف تكون في المحصلة مساهمة عربية عملية غير مباشرة في تمويل مشروع للأمن الفلسطيني مصمم لخدمة أمن الاحتلال أولًا وآخرًا، ولهذا السبب تحديدا استثنت العقوبات الأميركية المفروضة عقابًا للسلطة الفلسطينية على طلب اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين عام 2011 مبلغ (113) مليون دولار من مساعدات الولايات المتحدة كانت مخصصة لأجهزتها الأمنية.
إن رواتب ما يقدر بـ (37) ألف موظف في قطاع غزة تدفع لهم من موازنة السلطة لعدم الالتحاق بوظائفهم لا يمكن وصفها إلا كإجراء أمني أيضًا يندرج ضمن العقيدة القتالية لأجهزة أمن السلطة التي تعد “حماس” هي “العدو” وليس الاحتلال، حسب محاضر اجتماعات التنسيق الأمني التي نشرتها القدس العربي في 22/9/2008 مترجمة إلى العربية نقلًا عن يديعوت أحرونوت العبرية، وتوفير هذه الرواتب كفيل أيضًا بالمساهمة في دفع رواتب موظفي السلطة بانتظام في الضفة الغربية من دون الحاجة إلى “شبكة أمان” مالية عربية أو غير عربية.
صحيح أن تقليص حجم الأجهزة الأمنية وحجم حصتها من الموازنة العامة، وكذلك وقف صرف رواتب الموظفين غير العاملين في القطاع، سوف يلحق ضررًا فادحًا بالمستفيدين في الحالتين ويزيد من معدلي البطالة والفقر المرتفعين أصلًا، لكن إيجاد حل لهاتين الحالتين الشاذتين لا يتحقق إلا بوفاق وطني على الأمن كعقدة رئيسة ما زالت تحول دون المصالحة الوطنية حتى الآن.
فلسطين أون لاين، 12/1/2013